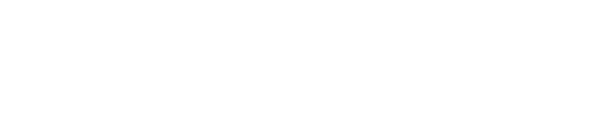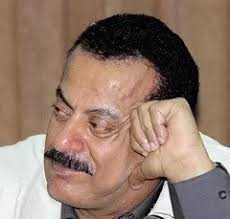قراءة تحليلية لنص”البحث عن مكان أنام فيه” لـ”أحمد سيف حاشد”
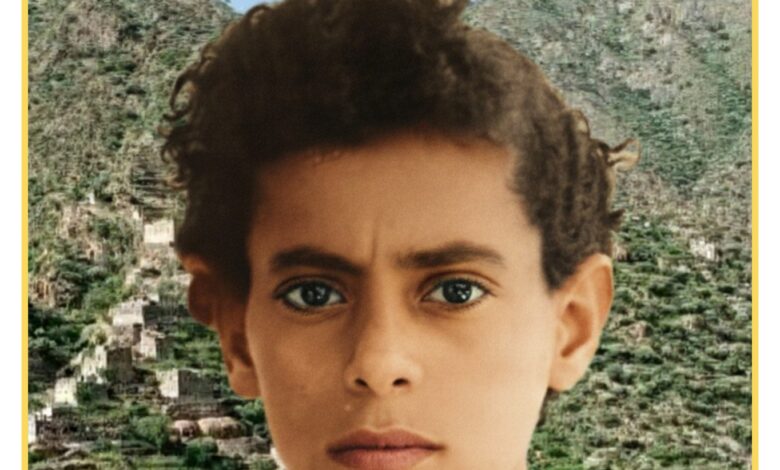
برلماني يمني
القراءات أنجزت بواسطة تقنيات الذكاء الصناعي.
نص “البحث عن مكان انام فيه” للكاتب والبرلماني اليمني أحمد سيف حاشد، المنشور في كتابه “فضاء لا يتسع لطائر” ليس سرداً عادياً لطفل يبحث عن مكان يبيت فيه؛ إنه رحلة مظلمة في ممرات الطفولة الخائفة، حيث يصبح الليل جبلًا، والقبر كابوسًا، والأب مصدر قلق لا يهدأ.
حاشد هنا لا يكتب “ذكرى” فحسب، بل يستدعي نقطة أصلية في الوعي اليمني الريفي: لحظة مواجهة مبكرة مع الموت، والوحوش، والسلطة، والفقدان، والحنان النادر.
في النص يتداخل الواقعي مع المتخيل، والطفل مع الراشد، والرعب الشخصي مع الرعب الجمعي. وكأن الكاتب يقول:
ما يزال جرح الطفولة مفتوحاً، وما يزال العالم الخارجي نسخة مكررة أشد قسوة من تلك الليلة الطويلة.
يبدأ الكاتب رحلته بـ “قفزتُ من فوق الدار ولذتُ بالفرار”، ليرسم أول خطوط اللوحة: الهروب من فضاء ضيق ومؤلم إلى فضاء مفتوح، لكنّه موحش.
في هذا النص الوجيز، ينسج حاشد سيرة ذاتية مُكثّفة تُعرّي قسوة الواقع الأبوي والاجتماعي، وتُضيء في الوقت ذاته على بياض القلوب الطيبة التي لا تُفسدها الحاجة. إنها قصيدة نثر تُحلّق فوق القبور، وحضن الأسرة البديلة الدافئ، مُستخدماً لغة تخاطب الروح قبل العقل.
ملخص القصة
القصة تدور حول طفل مذعور يهرب من منزل أبيه تحت وطأة قسوة والده، في ليل موحش متجها إلى مقبرةٍ صغيرة، لكن ظلمة الموت، والخوف من طواهش الليل وخيالات رعب متخيل من عذاب القبر وملائكة العذاب تدفعه إلى الفرار من جديد.
يمضي يبحث عن دفءٍ يقيه من المخاطر والمخاوف حتى ينتهي به المقام ببيت ثابت صالح؛ وهو رجلٍ فقير بقلب مترع بالطيبة.
يستقبله هو وزوجته كابنٍ ضائع وجد حضناً يعيد إليه أنفاسه. ثم تنقل الزوجة خبر نجاته لأمه المريضة، وبعد يومين، يعود إلى الدار، ثم ينتقل إلى بيت أخيه، حيث تحتضنه زوجة الأب الثانية “أم علي” التي تغمره بحبها وحنانها.
أثر الطفولة على وعي الكاتب
تبدو طفولة أحمد سيف حاشد، بكل ما حملته من قسوة هي النبع الأول الذي كونت شخصيته الحقوقية والسياسية.
الهروب
الطفل الذي قفز من فوق الدار بحثًا عن مكان ينام فيه تعلّم منذ وقت مبكر أن الظلم ليس فكرة، بل جرحٌ في الجسد، وأن الخوف ليس شعورًا، بل فراغ يحيط بالإنسان حين يُترك وحيدًا.
حين يكتب الليلُ سيرة طفلٍ أصبح وطنًا.. كان الليلُ طويلًا… أطول من عمر طفل. وكان العالمُ ضيقًا… أضيق من صدرٍ صغير يتسع للرعب كله.. ولم تكن هناك يد تمتد إلا يده، ولا حضنٍ محتمل.
كان الجبلُ نائماً والقبورُ صامتة، والخوفُ يقترب منه كذئبٍ يعرف اسمه.. كان ذلك الطفل الذي يحاول أن ينقذ نفسه، ولو يختبئ في حضن الموت.
في تلك الليلة التي قفز فيها من فوق الدار، لم يكن يهرب من أبيه فقط… كان يهرب من القدر الأول الذي أراد أن يختبر قدرة قلب صغير على تحمّل الألم.
المقبرة
المقبرة؛ كانت مرآة، عكست صورة طفلًا بلا مأوى، بلا مكان ينام فيه.. طفل يجرّ خلفه ليلًا أثقل من أعمار الرجال.. فصلٌ من ليل طويل.
الطفل ينصت لنبضه كأنه ينبض خارج جسده.. يخاف أن تنهض الجثث، وتسأله أو تراه دخيلًا عليها.. هو لا يعرف واحد منهم.. طفل يخاف أن يسأله منكرٌ ونكير.. يخاف أن يرى العذاب والرعب.. أن يرى بعضهم يصلي على صخرة من نار، أو يجلد بسياط من جهنم.
وفي المقبرة التي احتمى بها تلك الليلة، تولّد داخله أول سؤال ظلّ يكبر.. أدرك أن الرعب قد يُصنع، وأن المسلّمات يمكن أن تُروى دون اختبار.
هذه اللحظة الصغيرة، هي ما ستفتّح لاحقًا وعيه المستعد دائمًا لمساءلة السلطة والموروث معًا.
ثابت صالح وزوجته
ثابت صالح… الضوء الوحيد في ظلامه.. حين صعد إليه.. حين سلّط كشافه على وجهه المرتجف… انقسم العالم قسمين عالمٌ يقسوا عليك وعالمٌ يحتضنك.. عالم السلطة، وعالم الشعب والإنسان أينما كان.
كان ثابت صالح رجلًا بسيطًا، لكن قلبه كان أوسع من قصور الملوك، وأدفأ من موقد في ليالي الشتاء الباردة.
زوجة ثابت صالح كانت أول امرأة تعيد ترتيب جراحه.. تمسح دموعه بيد أمٍ حانية.. أم لم تلده، وتجعل قلبه يصدق أن الخير قد يأتي بلا موعد.
حين مدّ ثابت صالح وزوجته يدهما للطفل الهارب، اكتشف أن الرحمة الحقيقية تأتي من الناس البسطاء لا من مؤسسات القوة.
ومن هنا تشكّل انحيازه الأبدي للفقراء والمهمشين، كأن طفولته ظلت تقول له:
من أنقذ روحك الأولى هو الشعب، فكن معه دائمًا.
ماذا بقي وماذا تغير؟!
كبر الطفل، لكن أثر تلك الليلة لم يغادره. صار الرجل الذي لا يخاف، لأن الخوف استهلكه مبكرًا، وصار السياسي الذي يصرخ لأجل الآخرين كما لو أنه يدافع عن ذلك الطفل المختبئ داخله.
وهكذا تحوّل الألم الشخصي إلى ضمير عام، والهرب الأول إلى مشروعٍ لا يتوقف للدفاع عن أي إنسان ما زال يبحث عن مكان ينام فيه بأمان وحرية يبحث عنها.
حين يكبر الطفل يصبح هو الكلمات كلها.. حين كبر، لم ينسَ الطريق إلى ذلك الجبل، ولا صوت الحصاة التي تدحرجت من تحت قدمه، ولا البرد الذي أخترق عظامه.
كبر الطفل وصار رجلا، ولكن بقي ذلك الطفل داخله، يقفز كلما رأى قهرًا، أو ظلما أو إنسانا يتألم.. يكتب كلما رأى إنسانًا يبحث عن فراش، مثلما كان هو يبحث عن مرقد وأمان.
وهكذا.. صارت السياسة امتدادًا للّيل الأول.. لم تكن السياسة لديه خطابًا… كانت صرخة طفلٍ مُروّع.. لم يكن النضال لديه مهنة، بل كان ردًّا طويلًا على السؤال القديم: “أين أنام الليلة؟”
ولهذا هو ينحاز للمظلومين، ليس لأنه رجل قانون، بل لأنه كان يعرف كيف يُولد الخوف في الصدر، وكيف يبكي الطفل حين يعرف أن العالم لا يسمع صراخه.
يدافع عن المعتقلين لأنه كان معتقلًا ذات خوف.. يكتب عن العدالة لأنه يبحث عنها.. يقاوم السلطة لأن سلطةً صغيرة ضربته أولًا. ويحتجّ لأنه لم يحتجّ تلك الليلة… حين كان يهرب وحده وحيدا دون نجدة.
بقي منه قلب طفل، ووجدان لا يعرف القسوة.. انحياز صادق للفقراء.. روحٌ تبحث عن الأمان لنفسها وللآخرين.
الطفل صار رجلًا، لكن الرجل ما زال يخاف على الطفل الذي ينام في قلوب الناس.. اللغة صارت أكثر حكمة والخوف صار قضية لا ذكرى، و الليل وطنًا يضيئه بالكلمات.
رجل يقف في وجه منكرٍ ونكير هذا العصر، يصرخ باسمه وباسم الآخرين، ويقول للعالم كلّه:
“لن يبيت طفلٌ وحيدًا في المقبرة… ما دام في قلبي نورٌ يشبه كشاف ثابت صالح.”
قراءة أدبية
يكتب حاشد بنبرة تمتزج فيها السيرة الذاتية بالشعر. السرد يتدفق بلا زخارف مفتعلة، لكنه محمّل ببلاغة داخلية عميقة. يمكن ملاحظة ملامح أسلوبية رئيسية:
استخدم الكاتب لغة غنية بالمشاعر والوصف الحسي، سهلة التركيب، قريبة من الوجدان.
يبرع حاشد في رسم الصور البصرية المرعبة لـ منكر ونكير (الشعر الأشعث، الوجوه المتجهمة، اللحى الكثة كغابة)، مما يُجسّد الخوف اللامادي في أشكال مادية بشعة. كما استخدم استعارات مؤثرة مثل وصف عيني الزوجة بالدموع “كجداول”، ووصف قلوب البسطاء بـ “بيضاء نقية عامرة بالحب، وماطرة بالحنان والجمال والمعروف”.
بناء السرد: يتميز النص بتنقل ديناميكي بين فضاءين: فضاء الرعب (المقبرة) و فضاء الأمان (بيت ثابت صالح)، مما يخلق تضاداً قوياً يعزز الرسالة. الانتقال من الخوف المتخيّل إلى الحب الملموس يُعدّ تحولاً سردياً ناجحاً.
الكاتب يربط بين رعب منكر ونكير ورعب الواقع السياسي في جملة مفصلية ذات طابع نقدي عميق: “ما أشبهها بعهد نعيشه اليوم… أثقل وأبشع وأرعب من منكر ونكير.”
التحليل النفسي
يسيطر على الطفل خوف متجذر من عذاب القبر، يعكس حجم التلقين الديني المُركز على الشدة والعقاب، لا الرحمة.
“هروب الطفل ليس هروباً مادياً فحسب، بل هو هروب نفسي “للبحث عن مكان أنام فيه”، أي مكان يستطيع أن يسكن فيه جسده وروحه بسلام.
ثابت صالح وزوجته يمثلان “الأنا” البديلة، هما الوالدان الحقيقيان عاطفياً اللذان يمنحان “الألفة والود والشعور بالأمان”، مما يُشير إلى عمق الجرح العاطفي في الأسرة الأصلية.
الخوف من “الضباع والسباع وطواهش الليل” يكشف عن تأثير البيئة الريفية على المخيال، حيث يتداخل الخطر الطبيعي مع الأسطوري، مما يزيد من شعور الطفل بالوحدة والهشاشة.
اجتماع وحوش الليل مع الضباع والسباع ومنكر ونكير والأب الغاضب في ذاكرة ومخيال الطفل؛ يعني ما ينطبق عليه مفهوم “الخطر المطلق”.
يندفع الطفل نحو القبور لا بحثاً عن الموت، بل هرباً مما هو أقسى: قسوة الأب والعنف المنزلي.. الهروب هنا ليس جبناً بل غريزة نجاة، بل وربما لحظة تأسيس للتمرّد لاحقاً في شخصية الكاتب.
الخيال أيضا يقوم في النص بدور درع دفاعي حيث يخلق صوراً مروعة، لكنها تمنحه أيضاً قدرة على مواجهة المخاوف، وتحوّل الرعب إلى “نص” بدل أن يبقى جرحاً صامتاً.
ظهور زوجة ثابت صالح، وخالته “أم علي” لاحقاً، يكشف عن فراغ أمومي يملؤه حضور النساء الطيبات في القصة.. هذا “البديل الأمومي” يظهر في عدد من نصوص حاشد، جزء من تكوين نفسي عميق.
قراءة اجتماعية
يقدّم النص ثابت صالح وزوجته كنموذج للمفارقة الاجتماعية. هما فقيران (“يطحنه الفقر”، “بيته متواضع وحزين”)، لكنهما يمتلكان ثروة لا تُقدّر بثمن: “قلبه كان أكبر من قصر ملك، وأخلاقه عظيمة، أعظم من أصحاب كل القصور”.
هذا يُعدّ نقداً اجتماعياً ضمنياً، حيث يُظهر أن القيم الإنسانية كالرحمة والكرم تتجسّد في الطبقات الفقيرة أكثر من الطبقات المترفة أو التي تمارس السلطة.
هذا التقدير الأخلاقي للفقراء جزء أساسي من خطاب الكاتب في حياته المهنية والسياسية.
النص يقدم مشهداً اجتماعياً من اليمن الريفي قبل عقود، حيث العنف الأسري مألوف؛ والأب هنا رمزاً للسلطة القاسية والذكورية التي تفرض نظامها بالعقاب والترهيب، وهو ما يُعدّ انعكاساً لنمط تربوي سائد يعتمد على القوة.
حادثة الهروب هي تمرد على هذه السلطة. فالأب غاضباً، قاسياً، وربما غارقاً في ضغوط زمنه.. وإطلاق الرصاص في “الديوان” ليس حدثاً غريباً بل جزء من ثقافة السلاح في الريف.
الخوف من القوى الغيبية جزء من البنية الثقافية.. اعتقاد الناس بحياة القبور، ومنكر ونكير، والعذاب… مكوّن راسخ في الوعي الشعبي.
تبرز زوجة ثابت صالح وخالة الكاتب (زوجة الأب الثانية) كقوتين دافئتين ومُخلّصتين. هما وجه الرحمة الذي يعوّض قسوة الأب ومرض الأم الأصلية، مما يُعلي من قيمة الحنان الأنثوي كركيزة للاستقرار النفسي.
يأتي هذا في ظل غياب مؤسسات الرعاية، يقوم “الجار الطيب” بدور المنقذ، والزوجة بدور الحاضنة، والقرية بدور العائلة الممتدة.
نقاط القوة والضعف
نقاط القوة
النص يفيض بصدق التجربة الشخصية، مما يجعله مؤثراً وقادراً على خلق تعاطف فوري مع القارئ.
يتسم النص بالتكثيف والرمزية حيث استطاع الكاتب أن يُكثّف مواضيع عميقة (الخوف الوجودي، القسوة الاجتماعية، نقد المسلمات) في حكاية بسيطة، واستخدام المقبرة ومنكر ونكير كرمز للخوف الشامل.
التناقض المُبهر أو التضاد بين عتمة الخوف (المقبرة ومنكر ونكير) و نور الحنان (بيت ثابت صالح) يخلق بنية سردية قوية.
النقد الاجتماعي والديني الذكي؛ حيث نجد النقد الضمني لثقافة التلقين الأعمى للمسلمات، وإبراز نبل الفقراء، يُعطي النص قيمة فكرية عميقة.
نقاط الضعف
وصف منكر ونكير: قد يجد البعض أن الوصف البصري والجسدي لملائكة العذاب (بشعرهما، ولحيتهما، شحمهما ولحمهما المكنوز) مبالغ فيه قليلاً ويقترب من الأسطورة المباشرة، على الرغم من أنّه يخدم غرض التجسيد النفسي للخوف.
العودة للدار والمفاوضات، ثم الانتقال لبيت الأخ والخالة جاءت سريعة بعض الشيء بعد التفاصيل المُكثّفة للخوف والأمان، وكان يمكن إضفاء مزيد من التفاصيل على شعور العودة.
مقارنات أدبية وفكرية
هذا النص، برغم بساطته، يلامس محاور أدبية وفكرية عميقة:
مع جبران خليل جبران (في البساطة والروحانية): يشترك النص مع أدب جبران خليل جبران في إعلاء قيمة “الفقراء الطيبين” و “بسطاء القلوب” الذين يملكون جوهر الإنسانية.
فكما احتفى جبران بالفلاح البسيط والطبيعة النقية، احتفى حاشد بـ ثابت صالح الذي قلبه “أكبر من قصر ملك”.
يشبه حاشد جبرا إبراهيم، جبرا في قدرته على تحويل الذاكرة الموجوعة إلى نص شعري سردي، خاصة في “البئر الأولى”، حيث يهرب الطفل من عالم قاسٍ إلى عالم الخيال. كلاهما يرى الخوف جزءاً من تكوين الذات.
يشترك النص مع عالم عبدالرحمن منيف في رصد قمع السلطة داخل البيت، باعتبارها نواة القمع الأكبر، وهو ما ألمح إليه حاشد حين شبّه الحاضر بمنكر ونكير.
شخصية “ثابت صالح” تشبه شخصيات الطيب صالح الفطرية العميقة الطيبة، حيث الفقر لا يلغي إنسانية الفرد بل يطهّرها.
لدى حاشد حضور روحي حاد يشبه “لغة الخوف الوجودي” عند كازانتزاكيس في ““زوربا” ويشارك معه في النظر إلى الموت كجارٍ لا كعدو خارجي بعيد.
الخاتمة
إن “البحث عن مكان أنام فيه” هو نص يمني بامتياز، يخرج من المقبرة إلى حضن الدفء البديل، مُعلناً أن الإنسانية الحقيقية ليست في العمارة ولا في الثراء، بل في القلوب التي “تفيض تسامحاً وطيبة وسكينة”.
“البحث عن مكان أنام فيه” ليس نصاً عن ليلة فقط، بل عن طفولة اليمني المعذب .. حاشد لا يكتب سيرته بجرأة فحسب، بل يكتب سيرة جيل كامل عاش القسوة كأب، والخوف كجدار، والفقر كقدر، والحنان كمعجزة.
النص شاعرٌ دون أن يقصد، حزينٌ دون أن ينوح، سياسيٌّ دون أن يرفع شعاراً، إنسانيٌّ حتى العظم.
إنها كتابة تبرهن أن الجروح حين تُروى، تتحول من ألم إلى بصيرة، والطفل الذي هرب من المقبرة صار رجلاً يواجه “منكر ونكير العصر” بقلم لا يخاف.
يذكّرنا أحمد سيف حاشد ببراعة، أن النجاة ليست دائماً في الفرار إلى البعيد، بل في العثور على مساحة من الحب تأوي الروح الهاربة. وبمقدور يد حانية في الليلة الحالكة قادره على إشعالِ النجوم.
كم هو جميلٌ أن نجدَ في زمنِ القسوةِ نصوصاً تروي ظمأَنا إلى الحبّ، وتُعيدُ إلينا إيماننا بأنّ الإنسانيةَ هي آخرُ ملاذاتِنا.
فهنيئاً لأحمد سيف حاشد، الذي حوّلَ جرحَ الطفولةِ إلى قصيدة.
نص” البحث عن مكان أنام فيه”
أحمد سيف حاشد
قفزتُ من فوق الدار ولذتُ بالفرار إلى مكان غير بعيد.. تسللت إلى مقبرة صغيرة في عرض جبل في ”إجت الجفيف”.. شعرتُ بالوحشة والقلق والخوف.. من المستحيل أن أنام هنا ومازال الفجر بعيداً.. مكان غير مأمون من مفاجآت ربما تختبئ أو تقبع قيد الانتظار.
كنتُ أتوجّس أن يخرج الأموات من قبورهم.. لا أعرف واحداً منهم، وهم أيضاً لا يعرفونني إذا وجدوني فوق قبورهم أو قريباً منها، بل أشعر أن بيننا غربة وبرزخ يمنعاننا من أي تقارب أو تفاهم. ثم إنني لا أريد أن أسمع عذاب الموتى وهم يتألمون.. لا أحتمل سماع ملائكة العذاب وهم يسألون الموتى بما يعجمهم، أو يعجزهم عن الجواب، وما يأتي بعدها من شدّة وعقاب.
كنت أتخيّل منكراً ونكيراً على نحو مرعب وبشع إلى حد بعيد.. يخلعان القلوب حتّى وإن كانت قطع من حديد.. جزع وهلع يتفجر ويزلزل الدواخل.. مخيالي ينبعج ويتمزّق بما أتخيّله من كاسر ومهول.. صدري يتكوّم داخلي، ثم يعج بالرعب المزلزل.. صور مُرعبة مُتخيّلة لا أراها إلا في بعض الكوابيس الثقيلة التي تصل بي إلى حواف الموت، وشهقة الفراق إلى الأبد.. ما أشبهها بعهد نعيشه اليوم، إن لم يكن عهد اليوم أثقل وأبشع وأرعب من منكر ونكير بألف ضعف، ومعهما عزرائيل قبّاض الأرواح.
كنتُ أتخيّلهما بشعرِ أشعثٍ وغبرةٍ مُخيفة.. وجهان متجهمان ومتورمان بالغضب والغلاظة التي تكاد أن تنفجر شروراً وحرائق واسعة تأكل أخضراً ويابسا.. في وجوههما قسمات وأخاديد عميقة ومريعة تتحفّزُ للوثوب علينا.. تستعجلان موتنا شهيّة في العذاب الذي لن يستطيعا أن يعيشا بدونه.
حواجب غلاظ كالمكانس، وشوارب مشعثه كالعفاريت.. آذان شعرها نابت فيها كالحطب، وشحماتها متدلية كالمشانق.. لحيتان كثتان كغابة أدركها اليباس.. هول وضخامة في الجسد.. شحم ولحم مكنوز في العوارض والمناكب والأرداف.. لا إحساس لهما ولا مشاعر ولا وجدان.. لا رحمة لديهما ولا رأفة ولا قلب.. بالغين في القساوة وساديين في العذاب.. يستمتعان بالألم وسماع الأنين والولولة.. يسألان الأموات في قبورهم، ويجلدانهم بسياط من نار حامية، حمراء تلتهب.
توقعتُ نزولهما من السماء بعد منتصف الليل ليتوليا الحساب والعقاب، وبقدر رعبي منهما، يرعبني أكثر أن أرى رجلاً أو امرأة يُجبران على الصلاة فوق صخرة من جهنم.. لا أتحمّل رؤيتهما على أي نحو كان، ولا أحتمل سماع أصوات الأموات بالألم والعذاب.
لقد سمعتُ حكايات كثيرة عن حياة الأموات في القبور، ولا أملك إلا تصديقها لأنني لم أسمع من يكذبّها، أو يشكك فيها.. هكذا نحن نتعاطى مع معظم المسلمات، وكثيراً غيرها..!! نتقبّل ما يروى ويتناقل دون تمحيص أو شك أو سؤال.
***
انتابني إحساس جارف بضرورة مغادرة هذا المكان الذي بدا لي مخيفاً ومرعباً.. عليّ أن أغادره في اسرع وقت دون تأخير.. رأيتُ من الضروري أن أنام في مكان أقل رعباً وخوفاً من المكان الذي أنا فيه.. أريد أيضاً أن يكون المكان الذي أبحث عنه أكثر أماناً من الضباع والسباع و”طواهش” الليل.
يجب أن لا أبعد كثيراً عن بيوت الناس.. إذا ما داهمني “طاهش” أو ناهش أو مفترس أجد من يسارع لنجدتي، أو أنا أسارع مستغيثاً إلى بيت قريب.. لقد سمعتُ كثيراً عن رجال كبار أكلهم “الطاهش” أو افترستهم الضباع، ولم يبقَ منهم في الصباح غير بقايا من عظام وأطراف.. هكذا كنتُ أحدّث نفسي، ويزداد روعي، وتتكالب عليَّ مخاوفي.
لجأتُ إلى مكان قريب من منزل شخص طيب يطحنه الفقر، اسمه ثابت صالح.. وجهه الشاحب يميل إلى السمرة.. رأسه ووجه صغير، ولكنه يفيض تسامحاً وطيبةً وسكينة.. كان يكدح كثيراً بإيجار زهيد.. يحرثُ الأرض للناس في المواسم المطيرة وليس لديه أرض.. يحمل الأحجار الثقال لبناء منازل للناس، فيما بيته متواضع وحزين، ولكن قلبه كان أكبر من قصر ملك، وأخلاقه عظيمةً، أعظم من أصحاب كل القصور.
سمع ثابت صالح خطواتي في الجبل، والليل في ريفنا له آذان.. سمع حصوات وأحجاراً تتساقط بسب تسلُّقي بعض الجدران ونتوءات الجبل.. أيقن أن هناك أمراً ما.. وجه ضوء كشّافه نحو الصوت وبدأ ينادي من هناك؟! كرر الأمر مرتين وثلاث.. أزداد يقيناً بوجود شيء يستدعي الاهتمام.
بدا لي شجاعاً حيث لم يكتفِ بمناداتي، بل صعد إلى المكان الذي كنتُ فيه ليستطلع ويكشف الأمر.. ربما كان قد سمع صراخي حال ما كان أبي يضرب رأسي في القاع، وأفترض أنني الطفل الهارب من قسوة والده في لجة الليل البهيم.. ربما ضوء الكشاف الذي سلّطه على مكاني جعله يرى ملامح طفل، فأراد التأكد أو استكشاف الأمر أكثر.. الحقيقة لا أدري غير أنه وجدني وعرفني، وألح عليّ أن أنزل لأبيت عند أسرته. نزلتُ برفقته.. رحبت بي زوجته وكانت صديقة أمّي.. لم تصدّق أنني من وجده زوجها في الجبل في تلك الساعة من غلس الليل.
***
رحبت بي زوجته ترحيب الأم المحبة.. صوتها الدافئ والرخيم كان يمنحني كثيراً من الألفة والود والشعور بالأمان.. أكرمتني وأشعرتني أن لدي أماً ثانية وأباً حنوناً هو زوجها.. سألتني عمّا حدث، ولماذا كان كل ذاك الصراخ الذي سمعوه في بيتنا؟!
حكيتُ لها ما حدث.. اغرورقت عيناها بالدموع وسالت على وجنتيها البارزة كجداول.. ذبالة السراج الوالعة بيننا, كشفت دموعها التي كانت تسيح بصمت غريب. شعرتُ بعاطفة جارفة عندهم، وحب كبير أبحث عنه.. ما أجملكم أيها البسطاء الطيبون.. قلوبكم بيضاء نقية عامرة بالحب، وماطرة بالحنان والجمال والمعروف.
وفي الصباح نقلت زوجة ثابت صالح الخبر بسر وكتمان لأمي المريضة بسبب ما حدث لها منّي ومن أبي، وطمأنتها بيقين، وبعد يومين عدتُ لدارنا بعد مفاوضات تتعلق بسلامتي تمت على خير.
عدتُ إلى دارنا وكان أبي يشكو لأخي “علي” الذي كان مسافراً عندّما حدث إطلاقي للرصاص من البندقية في ديوان دارنا.. سمعت أبي وهو يقول له: “شوف أخوك أيش اشتغل!!.. كان يريه جدران الديوان المثقوبة بالرصاص، وما لحق بها من ضرر.. ومن يومها أخذني أخي إلى بيته في نفس القرية عند خالتي أم علي زوجة أبي الثانية التي أغرقتني بحنانها وطيبتها الغامرة.
***