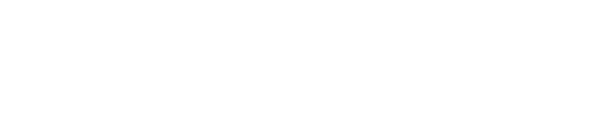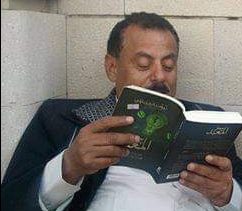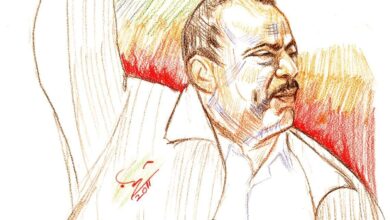قراءة تحليلية لنص “محاولة انتحار” لـ”أحمد سيف حاشد”

برلماني يمني
يقدّم نص “محاولة انتحار” للكاتب والحقوقي اليمني أحمد سيف حاشد تجربةً إنسانية جارحة تُستعاد بوعي كاتب تمرّس على تفكيك الألم وتحويل القسوة إلى معرفة.
في هذا التحليل الذي أنجز بتقنيات الذكاء الاصطناعي يتقدّم الاعتراف الشخصي ليغدو شهادة على مجتمعٍ يصنع القهر، وعلى قلبٍ واجه الظلمة بالحب، وعلى كتابةٍ تجرؤ على كشف الجرح لتبحث فيه عن معنى يُنقذ الإنسان من غضب العالم وقسوته.
مقدمة
لم يكن أحمد سيف حاشد يكتب سيرةً ذاتية عابرة، بل كان ينقش على جدار الوجود أسئلةً عن القهر والحرية، وعن العقد والانعتاق.
“محاولة انتحار!” صرخة مكتومة من ذاكرة الطفولة، مكتوبة بوعي رجل خَبِر الألم وتمرّس على قراءة العالم.
يتضمن النص نبرة نادرة تجمع بين رهافة الحس وقسوة التجربة.
والنص ليس مجرد سرد لحادثة عابرة من طفولة كاتب وبرلماني وحقوقي، بل هو تشريح عميق للنفس البشرية في أقصى لحظات العجز والقهر، وصورة مؤلمة لبنية السلطة الأبوية في مجتمع تقليدي.
رسائل النص
ماذا يريد الكاتب أن يقوله للناس من خلال قصته؟
1. رسالة ضد القسوة الأبوية وسلطة العنف
أراد الكاتب أن يعلن بوضوح :
القسوة ليست تربية، والعنف يترك ندوبًا لا يمحوها الزمن.
النص لا يصف زمن الطفولة فقط، بل يفضح فلسفة اجتماعية ما تزال حاضرة بيننا.
2. رسالة عن هشاشة الطفل وعمق جراحه
يحاول النص أن يهمس للعالم :
طفل واحد يُعذَّب… يصبح رجلًا يحمل ندوب عمرٍ كامل.
إنها دعوة لفهم أن:
• الطفل يرى العالم أكبر مما نرى
• القسوة تُضخّم الجرح
• والحرمان البسيط قد يتحول إلى رغبة بالموت
3. الأمّ بوصفها معجزة النجاة
الكاتب لا يكتب عن أمّه فحسب؛ إنه يكتب عن الأمومة كقوة كونية تمنع الموت.
حين يقول:
«لا أحد أحبّني كما فعلت أمي… وأقسم أن السماء تبكي حين تتألّم»
فهو يجعل من الأم جدار الحياة الأخير أمام السقوط.
رسالته:
لولا حنان الأمهات… لكان الموت أقرب إلينا مما نظن.
4. رسالة وجودية عن الحياة والموت
حين وضع البندقية تحت ذقنه، ثم تراجع بسبب “خوار بقرة” و”حب الأم”، كان يقول:
الحياة تنتصر أحيانًا بأسباب تبدو تافهة… لكنها عميقة.
وإن أقسى لحظات اليأس تمنحنا نافذة ضوء لا نتوقعها.
الخلاصة الوجودية
الحياة تستحق فرصة أخرى، مهما اشتد الظلم.
وفي داخل كل إنسان قوة خفية تقوده إلى البقاء
الخلاصة التي أراد الكاتب إيصالها
لقد نجوتُ من الموت بفضل الحب…
فامنحوا أبناءكم ما يستحقّون من الحنان.
يجب هدم فكرة الأب المتسلّط، وتعرية العنف الأسري، وإعادة الاعتبار للطفولة.
يجب فضح المجتمع الذي يجعل القهر منهجًا، ويحوّل الابن إلى ملكية.
– الرسالة المختزلة من كل ذلك:
“لا تقتلوا الحياة في صدور الأطفال… فقد يحتاجون عمرًا كاملاً لفكّ العقد التي صنعتها أيديكم.
وأعظم الانتصارات انتصار الإنسانية على القسوة، والحب على الموت.
مكامن القوة والضعف في النص
مكامن القوة
1. الصدق العاطفي العميق:
النص يغوص مباشرة إلى الطبقات الأكثر هشاشة في الذاكرة الإنسانية؛ يلمس مناطق لا يحرسها سوى الألم، فينبض بصدقٍ نادر لا يُصطنع ولا يُصاغ، بل يُعاش.
2. لغة عالية وشاعرية صادقة:
جاءت اللغة مشدودة كوتر، وفي الوقت نفسه رقيقة كخيط من ضوء؛ صورها محكمة، متدفقة، خالية من الزخرف المتصنّع. كل صورة فيها تحمل أثر يد كاتب يعرف كيف يُمسك بالكلمة حتى آخر شهقتها.
3. تداخل الأدب بالفلسفة والنفس:
النص ليس سردًا فحسب، بل تقاطعٌ لأجناس متعددة: أدبية، وفلسفية، ووجودية. إنه نص يفتح نوافذ تأويل لا تُغلق، ويقدّم نفسه كحقل ثري لقراءات متشعّبة.
4. تحويل لحظة شخصية إلى معنى كوني:
هذه واحدة من قُدرات الكاتب اللافتة؛ إذ يحوّل ذكرى طفولية خاصة إلى سؤال إنساني كبير عن القهر والحرية، عن الحياة والموت. وهذا من سمات الأدب الذي يعبر حدود التجربة الفردية ليصل إلى القارئ أينما كان في العالم.
5. رمزية البقرة والأم كقوتين مانعتين للفناء:
يمنح الكاتب للبقرة والأم بُعدًا وجوديًا عميقًا؛ تتحولان من شخصيتين عابرَتين إلى قوّتين كونيّتين تردعان الموت وتعيدان الحياة إلى مسارها. حضورٌ يفيض حنانًا ويكشف هشاشة الروح حين تتعلّق بما يمنحها الأمان.
مكامن الضعف في النص
1. انفعال طاغٍ في بعض المقاطع :
تسرف بعض السطور في فيضان الشعور، فيخفتُ الاتزان البنائي قليلاً، على الرغم من أن هذا الانفعال ذاته هو جزء من جمال النص وجروحِه المكشوفة.
2. إطالة في المشاهد الوجدانية
تمتد بعض اللحظات الوجدانية أكثر مما يحتمل البناء، غير أن طبيعة النص الاعترافية تبرّر هذا الامتداد؛ فالألم حين يُكتب لا يعرف الاختصار بسهولة.
3. تكرار في بعض الصور والأفكار
تعود بعض العبارات المرتبطة بالموت والرصاصة والصوت على نحو قد يُخفَّف لو أُعيد تكثيفه، لكن التكرار هنا يبدو أحيانًا كارتجاج ذاكرة أكثر من كونه خللاً سرديًا.
ورغم هذه الملاحظات، تبقى ما يُعدّ «عيوبًا» جزءًا من صدق النص وجماليته؛ فالكتابة حين تخرج من قلبٍ موجوع لا تأتي مصقولة بالكامل، بل نابضة، حيّة، وممتلئة بما يجعلها أكثر إنسانية وخلودًا
التحليل الأدبي والبلاغي
1. البناء السردي والتوتر الدرامي
يتكئ النص على أسلوبية آسرة، تنبض بنثرٍ مُشحون بالعاطفة، وبصورٍ حسيّة تجسّد المشهد بدل أن ترويه. فالكاتب لا يكتفي بأن يروي الألم، بل يعيد خلقه؛ يجعل القسوة ملموسة، والحرمان يشتعل في الذاكرة.
يبدأ السرد من ضيق القيد ووجع الحرمان.. ثم يتدرّج في خطّ تصاعدي محتدم، يتحوّل فيه الحرمان البسيط إلى مواجهة مع الوجود ذاته.
وكلما تقدّم النص، تقلّصت براءة الطفولة واتسعت مساحة التراجيديا، حتى يبلغ السرد ذروةً خانقة عند لحظة وضع فوهة البندقية تحت الذقن؛ تلك اللحظة التي تتكثّف فيها كل طبقات الألم، ويصبح الصوت المتخيَّل للرصاصة مرآةً لما تراكم من قهر.
2. اللغة والصور
اللغة هنا شاعرية دون أن تتعثر في زخرفة، مفعمة بمجازات حسية دقيقة، تمنح النص بعدًا أسطوريًا، وتجعل العقاب مشهدًا أقرب إلى طقسٍ صلبٍ غير معلن، تتشكّل من خلفه فلسفةُ الكاتب القديمة عن الألم وقدر الإنسان.
ويبلغ النص ذروته الفنية في تشخيص البقرة؛ إذ تتجسد ككائن مُلهِم ذي معنى داخلي، تكتسب صوتًا بلا لغة، وحضورًا بلا كلام، فتغدو شخصية ثانية في السرد. هذا التشخيص يكسر واقعية النص ويمنحه نفَسًا من الواقعية السحرية، فيتداخل الحقيقي بالرمزي، والطفولي بالأسطوري.
3. الزمن والذاكرة
يعتمد النص على كتابةٍ استرجاعية، يستعيد فيها الراوي طفولتَه بوعي رجل جرّب الحياة واختبر قسوتها. وبهذا التداخل بين زمن الطفل وزمن الراشد، يكتسب السرد عمقًا وحكمة؛ إذ تبدو الحادثة الصغيرة وهي تُروى بعد عقود كأنها مرآة تُظهر ما خفي من طبقات النفس وتحوّلاتها.
والذاكرة لا تعيد الحدث كما وقع، بل كما ظلّ ينزف داخليًا، ولذلك تأتي الكتابة هنا أشبه بعودة متأخرة إلى جرح قديم، لا ليُرمّم، بل ليُفهم ويُكتب، فيكتسب معنى جديدًا لم يكن ممكنًا في لحظته الأولى.
التحليل النفسي
1. أثر العنف الأبوي
النص نموذج دقيق لما يسميه علم النفس التحليلي «صدمة السلطة الأبوية» الأب هنا ليس فردًا؛ بل بنية سلطوية، يمثل:
• القمع
• العقاب
• الحرمان
• كسر الإرادة
ويبدو الطفل في مواجهة سلطة مطلقة، تمامًا كما في تحليل فرويد لعقدة الأب، حيث تبقى صورة الأب قاسيًا أو متجبرًا محفورة في لاوعي الطفل حتى شيخوخته.
النص يكشف أن الانتحار لم يكن رغبة في الموت، بل رغبة في إيذاء الأب نفسيًا؛ هذا ما يسميه فرويد «القتل المعكوس».
2. دور الأم كقوة خلاص
الأم في النص «حضور كوني»؛ هي العاطفة، التضحية، و«المحبّة التي تبكي لها السماء». فالأم ليست شخصية فقط؛ إنها سبب النجاة، وهي التي انتصرت على فكرة الموت.
3. العلاقة الرمزية مع البقرة
الرابط بين الطفل والبقرة رابط إسقاطي إسعافي. البقرة هنا ليست حيوانًا؛ بل بديل نفسي للأم، «أنا حامية»، «أنا بريئة»، «أنا أحبّك دون شروط».
البقرة صارت «ملاك نجاة»، وكأن الكون كلّه أرسلها لردعه.
التحليل الاجتماعي
1. العنف التربوي في الريف اليمني
النص وثيقة اجتماعية عن شكل من أشكال السلطة الأبوية في مجتمع تقليدي:
• الأب سيّد مطلق
• الأم عاجزة وإن كانت حنونًا
• الابن ملك لأبيه
هذا الوصف يفضح نسقًا ثقافيًا ما تزال بقاياه راسخة في المجتمعات الريفية التي تتغذى على مفاهيم الطاعة والرجولة المبكرة.
2. الاحتفال الديني «المولد» ودلالته
«المولد» ليس حدثًا بسيطًا؛ إنه رمز للفرح الجمعي، للخروج من الرتابة، للانتماء الاجتماعي. حرمان الطفل منه هو حرمانه من العالم، وهذا يوضح لماذا كان الألم مضاعفًا.
3. موقع الأم في البنية الاجتماعية
الأم لا تقوى على مواجهة الأب، وهنا يظهر الصراع داخل الأسرة ذاتها:
سلطة أبوية في القمة، وأنوثة مقهورة في القاع.
الأم تمثل «المظلوم الأبدي» الذي رغم ضعفه هو مصدر الحياة والأمل.
التحليل الفلسفي
1. الموت بوصفه احتجاجًا
الانتحار هنا ليس رغبة في الفناء، بل فعلًا وجوديًا احتجاجيًا يشبه فلسفة ألبير كامو في «أسطورة سيزيف»، حين يقول إن الانتحار هو سؤال الفلسفة الأول:
«هل تستحق الحياة أن تُعاش؟»
الطفل أراد أن يجيب الأب بسلاح الموت.
2. غريزة البقاء ومكر الحياة
على طريقة نيتشه، تظهر «إرادة الحياة» أقوى من إرادة الفناء. فحتى حين يقرر الطفل الانتحار، تأتي الحياة في هيئة بقرة وأم وذكريات – لتقنعه بالبقاء.
3. الحب قوة كونية
في هذا النص، الحبّ ليس شعورًا؛ إنه «قوة كونية» تمنع الرصاصة من الانطلاق.
والمقارنة التي عقدها الكاتب مع عبارة د. عبد الرحمن فارع «لأجل الأحبة أقدّس الحياة» هي مقارنة وجودية دقيقة، وكأن الحب هو نجاتنا الوحيدة في عبث هذا العالم.
مقاربات
يلتقي النص مع دوستويفسكي في كشفِ قاع النفس عند حافة الانتحار، حيث يتحوّل الألم إلى سؤالٍ وجودي معلّق بين الظلمة والخلاص.
وتنهض البقرة في النص كما تنهض الأشياء في عالم ماركيز؛ تفاصيل يومية تتجاوز مادّيتها لتغدو طوق نجاة وروحًا تُعيد الإنسان إلى الحياة.
كما يستعيد الكاتب طفولتَه على طريقة طه حسين، لا ليحكي فقط، بل ليُعرّي القسوة الاجتماعية وخلل التنشئة الأبوية في مجتمع تقليدي لا يرحم.
ويوازي تصعيد الحدث ما فعله نجيب محفوظ حين حوّل الشرارة الصغيرة إلى قدر ضاغط يعيد تشكيل وعي البطل ومسار حياته.
أما صرخة الابن المقهور فتجاور سؤال غسان كنفاني الأزلي: لماذا يُدفع المظلومون إلى الموت صامتين؟
وفي مواجهة الرصاصة تتبدّى ظلال كامو: عبثٌ يُفضي إلى اختيار الحياة، لا لأنها أجمل بل لأنها أثقل وأصدق.
وأخيرًا، تلوح الأم في النص كما تلوح عند محمود درويش: قَدَرًا منقذًا، بيتًا يحول دون سقوط القلب في الهاوية.
خاتمة
«محاولة انتحار!» ليست مجرد سرد لطفولة قاسية؛ إنها شهادة على صراع الإنسان ضد القهر، صراع بين سلطة الأب وسلطة الحياة، بين الموت بوصفه احتجاجًا والحياة بوصفها انتصارًا.
إنها كتابة تتقاطع مع تيارات أدبية عالمية، وتُثبت مرة أخرى أن أحمد سيف حاشد لا يكتب التجربة فحسب، بل يكتب المعنى المختبئ خلف التجربة.
هذا النص، بشاعريته وجرأته وجرحه، يضيف لبنة جديدة في أدب الاعتراف العربي، ويذكّرنا بأن الكتابة كما يقول سارتر ليست إلا محاولة للفوز في معركة ضد الموت.
نص “محاولة انتحار!” لـ”أحمد سيف حاشد” هو ترياق أدبي مضاد للقسوة، يغوص في أعماق تجربة طفولية قاسية، ليخرج بدرس وجودي خالد: الحياة تنتصر ليس بالمنطق أو الواجب، بل بالإيثار والحب غير المشروط.
نص “محاولة انتحار!.”
أحمد سيف حاشد
حاولتُ التحدِّي والذهاب عنوةً “مولد الخضر”، ولكن أبي كتّفني وربطني إلى عمود خشبي مغروس في قاع دكانه.. ضربني بقسوة، أحسستُ منها وفي ذروتها أن صاحبها قد نُزعت منه كل شفقة ورحمة.. ظللتُ مربوطاً على العمود الخشبي حتّى جاء الرواح، وفات موعد الذهاب إلى “المولد”، وفات معه عام من عمري المثقل بالانتظار.
كنتُ أستعجل وقت عقابي، وأتمنّى أن لا يطول؛ لعل وعسى أن أدُرِكَ بصيصاً من أملٍ ألحق فيه ساعة من “المولد” قبل الرواح، بمجرد إطلاق سراحي، غير أن أبي فطنَ بما يجوس داخلي، وما استقر عليه عزمي؛ فتعمدَ إطالة عقابي الثقيل، حتّى يدركني اليأس الأكيد من أن ألحق بقايا ذلك “المولد” الذي لن يعود إلا بعد عام طويل.. فُلَّ عزمي وأفل أملي، وتلاشى ما صبرتُ عليه، وقطع اليأس كل محاولة.. لا ذهاب لي ولا رواح، ولا جدوى من أي مسعى أو محاولة. كان الزبائن من مختلف الأعمار يأتون لشراء حاجاتهم من دكان أبي، ويمعنون النظر نحوي، وأنا مكبّل بحبل وثيق ومشدود.. مصلوب قعيد على عمود من خشب.. كان بعضهم يرمقني بحسرة وتعاطف جم، فيما حاول البعض تودد وتوسل أبي دون جدوى، ودون قدرة أن ينقذوني مما أنا فيه.. هنا “الابن ملك أبيه” كالعبد في عهد الرق مِلكاً لسيّده. وبعد فوات موعد الذهاب إلى “المولد”، وتلاشي الأمل أن أدرك قليلاً منه، تركني أبي مربوطاً على حالي، وذهب إلى “رأس شرار” ليجزّ الزرع في موسم الحصاد، فيما أمّي بعد انتظار، وغصص، وسيل من الدموع، هرولت إليّ وفكّت وثاقي، وحضنتني كابن مفقود عاد إليها بعد غيابٍ وانقطاع.. غَشَتني بعطفها وواستني بكلمات من وجع وتصبير.. أمطرتني بنظرات حسرتها وقلة حيلتها مع أبي، ثم ذهبت بعد عطف ورفق وحنان، لتجلب الماء من البئر، فيما كنتُ أحاول أداري نوبة سخط وانفعال واستنفار للانتقام من أبي، حتّى وإن كان بانتحاري.. أردتُ أن ألحِق به أكبر قدر من الغيظ والندم على ما فعله معي.
* * *
بعد أن خرج الجميع من الدار، أغلقتُ بابه من الداخل، وصعدتُ إلى حجرة أبي أعلى الدار، ووجدتُ هناك سلاح والدي قد صار في متناول يدي.. كنتُ أتخيل لحظة إطلاق الرصاصة على رأسي من أسفل ذقني.. أسمع صوتها يدوّي في رأسي كـ “الصرنج”.. أشعر وكأنني أسمعها حقيقة مدوية وصارخة.. ثم أتخيّل جُثتي، وقد خَررْتُ صريعاً في قاعة الغرفة، وما تلاها من همود وخمود، ونزيف يسيح في القاع، ورأسي المثقوب برصاصة لأقتل فيها أبي ثأراً وانتقاماً من ممانعته وقسوته وغلاظته.
لم أكن أعلم أن بعضاً من رأسي سيتطاير على الأرض والجدار نثاراً وقطعاً صغيرة.. لم أكن أعلم أنني لن أسمع صوت الرصاصة التي سأطلقها على رأسي.. نعم.. لم أكن أعلم أن الرصاصة التي سوف تقتلني لن أسمع صوتها.. لم أكن أدري أن سرعة الرصاصة أسرع من سرعة الصوت، وأنني سأموت قبل أن أسمع صوتها.
كنتُ أعلم أن رصاصة واحدة في الرأس تكفي لأن تقتلني على نحو أكيد، بل وقادرة على أن تقتلني مرتين إن كان لنا أن نعيش الحياة مرتين.. كنتُ أتخيّل أن مفارقتي للحياة ستكون بعد لحظة من إطلاق الرصاصة، ولكن ليس قبل أن أسمع صوتها.. كنتُ أحاول أن أعيش اللحظة كما ارتسمت في وجداني ومخيال طفولتي.
أخذتُ بندقيته الآلية، وعمّرتُها وتمددتُ، ووضعتُ فوهة ماسورتها بين عنقي ورأسي، ووضعتُ أصبعي على الزناد، وأخذت بالعد ثلاثة لأبدأ بإطلاق النار.. واحد.. اثنان، وقبل أن أطلق الرصاص بالرقم ثلاثة، سمعتُ خوار بقرة أمّي، وكأنها رسالة الكون لي لإرجاعي عمّا عزمتُ عليه!! أحسستُ أن بقرتنا تريد منّي نظرة وداع أخيرة أحتاجها أنا أيضاً، وربما تريدني هي أن أكف وأرجع عمّا أنتوي فعله، وربما غريزة البقاء كانت أقوى منّي، ولكنها تبحث عن عذر مُقنع أمام نفسي..!
ذهبتُ لأراها وألقي عليها نظرة وداع أخيرة، وأول ما رأيتُها شعرتُ أنها تترجّى وتتوسّل بألا أفعل..!! هذا ما خلته في خاطرة مرت على بالي القِلق والمضطرِب. أحسستُ أنها مسكونة بي ولا تريد لي بعداً أو فراق الأبد.. قبّلت ناصيتها، ومسحتُ ظهرها، وراحت كفّاي تداعبان عُنقها حتّى ضممته بحرارة مفارق.. كانت تصرفاتي معها ربما ترتقي إلى تصرفات الهنود مع البقر، كأنها إلّه أو معبود مقدس.
لا وحي نزل، ولا جبريل اعترض، ولا معجزة نهضت وقالت “لا تفعل بنفسك ما تنتوي فعله”.. كنتُ أشعر أنني بأمس حاجة إلى معجزة تقول لي ما لا أجرؤُ أنا على قوله، بل وتأمرني بالكف عن قتل نفسي.. فقط, بقرتنا وحدها التي مالت إليّ وأحسستُ بحبّها الجارف، وبادلتها محبّة غامرة.. شعرتُ أنها تبادلني حميمية لم أشعر بها من قبل.
غالبتُ دموعي، ولكنّها كانت تنهمر سخينة.. رأيتها تشتَمُّني بلهفة، وكأنها تريد أن تحتفظ بتذكار إن عجزت عن إقناعي في العدول عن قرار أخذته بحق نفسي وبحق الحياة.. أحسستُ أنها تغالب دموعها.. بقرتنا المحروسة من العين بحرز معلّق على رقبتها كمصد يصدُّ العين والحسد. وأنا المحروس أيضاً بحرز السبعة العهود من الجن والشياطين، ولكن من يحرسني من قسوة أبي؟!!
قطعتُ اللحظة، وذهبتُ لأسرق لها الطحين، وأصبُّ عليه الماء، وأقدّمه لها كحساء وداع أخير.. أمطرتُها بقبل غزيرة، بدت لي أنها قُبلات الوداع الأخير.. وفيما أنا ذاهب عنها، رأيتها ممعنة بالنظر نحوي.. أحسستُ أنها تتوسّل وتترجّي أن ألا أفعل وأن لا أرحل عنها، وعن الحياة التي يجب أن أعيشها.
كنتُ أفسّر الحميمية التي بيننا على مقاس تلك اللحظة التي أحسُّ بها كثيفة وممطرة، أو بما ينسجمُ معها من أحاسيس ومشاعر جارفة.. كانت مناجاة ومحاكاة لها عمق في نفسي، وتفيض بمشاعر وعواطف جياشة بدت لي حقيقية، لا وهم فيها ولا سراب.
* * *
تطلّعتُ صوب الجبل والشجر والحجر أودع الجميع.. شعور وداع الأبد ليس مثله وداع.. الوداع الأبدي يجعلك ترى كثيراً من تفاصيل الأشياء قبل الرحيل، ربما لا تراها في أحوال ما هو عادي ومعتاد.. وجدتُ نفسي أودع كل شيء بما فيها التفاصيل التي لا تخطر على بال، فأنا على موعد مع الموت واستيفاء الأجل.. كنتُ أتفرّس في كل الأشياء التي يقع عليها نظري وكأنني أراها للمرّة الأولى.. الجدران والخشب والأواني وملابس أمّي وأخواتي.
تذكرتُ أمّي وحب أمّي.. أمّي التي ضَحَّت بأشياء كثيرة من أجلي.. أمّي التي تشربت ألف عذاب، وصبرت لأجلي وإخوتي على حمل ما لا تحتمله الجبال.. عاشت أمّي صراعاً لا تحتمله أرض ولا سماء.. كنتُ أشعر ببكاء السماء في كل مكروه يصيبها.
ربما في لحظة لم أكن أتخيّل أن ثمة شيئاً يثنيني عن الانتحار والذهاب إلى جهنم، ولا حتّى بقرتنا الطيبة، لكن ربما غريزة البقاء غلبتني، وربما حب أمّي هو من غلبني أكثر، فلا يوجد شخص أحبني أكثر من أمّي.. تذكرتها وهي تكرر لي فيما مضى قولها: “إن حدث لك مكروه سأموت كمداً وقهراً”.
لا أستطيع أن أتخيّل أمّي وهي تراني منتحراً ومضرجاً بدمائي.. كنتُ أتصور أن مشهداً كهذا سيكون صادماً وفاجعاً للإنسان الذي أهتم به؛ مشهداً لا استطيع تخيُّل مأساته الثقيلة على أمّي التي تحمّلت الكثير من أجلي.. مشهداً لن يحس بمدى فاجعته غير أمّي التي لا شك سيكمدها الحدث إن لم تخر صريعة من الوهلة الأولى.
مقارنة مع الفارق.. كثيف ومقارب في الإيثار والحضور ذلك التصوير الذي قرأته بعد قرابة الخمسين عاماً في آخر منشور للدكتور عبد الرحمن جميل فارع وهو على فراش الموت: “لأجل الأحبة أقدّس الحياة وأتمسك بها يا ألله” .. نعم إنهم “الأحبة” العنوان الذي كان حاضراً بوجه ما حال بين عدولي عن قرار الانتحار، وانتقالي إلى قرار آخر.
بسبب أمّي وحبها وأخواتي الصغيرات أحجمت عن الحماقة لتنتصر الحياة على الموت؛ ولا بأس من احتجاج أرفق وأخف ضرراً وكلفة، وهو ما سأقدم عليه الأن لأغيظ به أبي بدلاً من الانتحار.. هكذا جاس الكلام لحظتها في وجداني المشتعل، وكان العدول إلى قرار هو أخف ضرراً وأقل مقامرة .
* * *