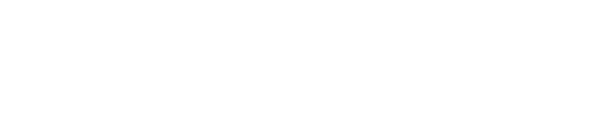قراءة تحليلية لنص “فرار وقت صلاة المغرب” لـ”أحمد سيف حاشد”
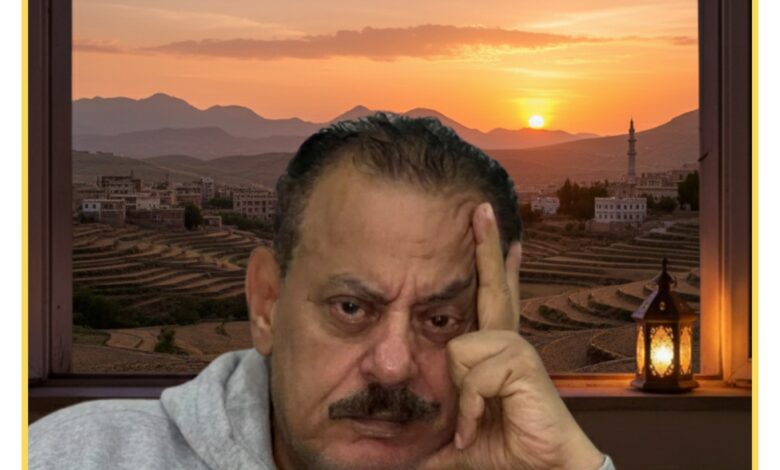
برلماني يمني
أحمد سيف حاشد ونصه “فرار وقت صلاة المغرب” في قراءة تحليلية متنوعة بمساعدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
الكاتب كما تبوح به ظلال نصّه
إذا أطللنا على شخصية أحمد سيف حاشد من نافذة نصّه، بدا لنا كاتبًا يمشي في أدبه كما يمشي القلب في عتمته: صادقًا، جريئًا، ومحمّلًا بوهج التجربة وارتجافاتها.
يطلّ علينا من بين أسطره كمن يخرج من مرآة بعيدة؛ في اعترافه دفءٌ لا يقدر عليه إلا من تصادق مع وجعه، وجرأةٌ لا يملكها إلا من تعلّم كيف يخلع أقنعته على مهل.
1. صدقٌ فنيّ وجرأة في البوح
يتبدّى حاشد كمن لا يخشى أن يضع طفولته على الطاولة بكل رهافتها وخدوشها.
يحوّل التجربة الشخصية إلى فنّ نابض، ويكشف هشاشة الطفل وقسوة الأب في لحظة واحدة، وكأنه يشرّح ذاته بمبضع الوعي لا بمبضع الألم.
هذا البوح الشفيف لا يصدر إلا عن كاتب بلغ من النضج ما يجعله قادرًا على مواجهة ماضيه دون خوف من ظله.
2. غوص في مياه اللاشعور
لا يكتفي الكاتب بوصف الهروب، بل ينفذ إلى جذوره الخفية: رغبةٌ دفينة في معاقبة الأب، وتمنٍّ مبطن بأن يفقده ليدرك قيمته الغائبة.
هكذا يتحول النص إلى مرآة نفسية تكشف عمق المعركة الداخلية بين الحب والتمرّد، بين الألم والرغبة في الاعتراف.
إنه وعيٌ حادٌّ بالطبقات المظلمة داخل النفس، وجرأة على الإنصات للهمس الذي لا يُقال.
3. توقٌ إلى لحظة التناغم الروحي
عند عتبة المشهد الختامي، يميل الكاتب إلى تلك اللحظة التي يذوب فيها الجفاف، وينهار فيها جدار الصمت بين الأب وابنه.
إنه يفتّش عن المصالحة التي تأتي بعد الإعصار، عن الهدوء الذي يهبط حين يتعب الغضب، وعن تلك اللحظة الصادقة التي ينكشف فيها الحب بلا أقنعة ولا كبرياء.
وهذا الميل يكشف روحًا تحنّ إلى الانسجام، وتؤمن بأن الندم الصامت أبلغ من الكلام حين يثقل الكلام.
4. شاعرية تلتقط التفاصيل وتنفخ فيها معنى الوجود
تنهض صور الكاتب من تفاصيل بسيطة، لكنها تتحول تحت قلمه إلى علامات وجودية وأسئلة كبرى يحملها طفلٌ يعبر المساء وحده:
«أأهرب لأنني أخاف؟ أم أخاف لأنني هربت؟»
هكذا تتداخل الواقعية مع الفلسفي، والطفولة مع الحكمة، ليظهر لنا كاتبٌ يرى العالم بوضوح شاعرٍ يلتقط من التفاصيل صوت الحياة كلها.
ثانياً: ملخّص النص
هرب الطفل من أبيه مذعورًا وقت صلاة المغرب إثر خلاف أو مشكلة بينهما. غير أن إحساس الطفل بالقهر دفعه إلى الفرار بعيدًا عن أي مكان سهل يمكن أن يعثر عليه فيه والده.
يمضي الطفل في ظلمة تتكثف، راكضًا حتى الإنهاك، إلى أن يبلغ بئر نعمان حيث يقرّر المبيت قريبًا من النسوة اللواتي يأتين لجلب الماء.
الليل يمتلئ بالمخاوف: حشرات، سحالي، أصوات، ظلال، وسواد يقترب على هيئة امرأة من المهمَّشات تُدعى رسلة. تكتشف وجوده وتشعر أن وراءه سرًا، فتتجه إلى دكان نعمان وتبلغ الحُرّاس.
يأتي الحارسان، سعيد عبدالولي وموسى راشد، يطمئنان الطفل ويقنعانه بالعودة. وفي الطريق يحدث اللقاء المصادف مع الأب.
يظهر الأب هذه المرة بشكلٍ مختلف: مذعورًا، خائفًا، محاولًا إخفاء عاطفة جياشة. ينتهي النص بمشهد عودة صامتة، لكنها غنية بحمولتها العاطفية: ندم غير معلن، ومصالحة بلا كلام، ودفء مكتوم تحت جناح الليل.
النص باختصار هو رحلة في ظلام القرية وظلام النفس معًا، تنتهي بضوءٍ خافت هو دفء الأب الذي لم يعرف كيف يقول: “أحبك”.
مقدمة
ينساب نص “فرار وقت صلاة المغرب” كهمسة اعترافٍ دافئة تخرج من قلب طفلٍ ضاقت به مساحات الطمأنينة في كنف أبيه.
إنها ليست مجرد حكاية هروبٍ جسدي، بل رحلة داخلية عميقة تتشابك فيها قسوة الأبوة بعناد الطفولة، ليغدو الحب سرًّا مكبوتًا خلف ستارٍ كثيف من سوء الفهم وصلابة المواقف.
لقد كان الفرار، بكل قسوته، الطريقَ الوحيد ليُدرك الأب أن ابنه كائنٌ هشّ يتوق إلى عطفه؛ بينما قاد الفرارُ الابنَ إلى إدراك خوف أبيه. فغدت اللحظة الصامتة الأخيرة بينهما إعلانًا بليغًا لما عجزت عن البوح به الكلمات والاعتذارات المؤجلة.
تكثيف: ظلٌّ يبحث عن مرآة
ينفتح نص “فرار وقت صلاة المغرب” كوميض طفلٍ يختنق في ظلّ أبٍ أثقلته الصرامة.
ليس هروبًا فحسب، بل ارتعاشة قلبٍ تتنازعها طفولةٌ تبحث عن يدٍ حانية، وأبوةٌ لا تعرف كيف تُظهر حبّها إلا بحدّتها.
يُجسّد النص ليلة الهروب كنقطة تحوّل لا كحدث عابر؛ اللحظة التي انفتح فيها الباب على الحقيقة المكبوتة: الأب الذي يخاف أن يُظهر خوفه، والابن الذي يخاف ألّا يُحب.
الفرار هنا رحلة نفسية قبل أن يكون جسدية: محاولة لمغادرة وجعٍ لم يجد له الطفل اسمًا، وإعلان صامت برغبة في أن يشعر الأب بما شعر به هو. وفي المقابل يتصدّع الجبل الأبوي الذي ظنّ القسوة ضرورة، ليكتشف أن الأبوة ليست قوة بل خوف عميق من الفقد.
في ذلك الليل يصبح الهامش – رسلة المهمشة والحراس – أكثر وعيًا بالشرخ العائلي. أما الطفل فقد مشى بوعيٍ مزدوج: طفل يرى الخوف، ورجل يرعى صورته، متسائلًا عن جدوى الهروب وسط ارتعاش الظلال وخشخشة الأوراق.
لم يكن المشهد الأخير انتصارًا لأحد، بل اعترافًا صامتًا يخرج كنورٍ خافت من مصباح قديم: اعتراف بأن الحب إذا قُمِع صار خوفًا، وأن طريق الخوف الطويل كان لا بدّ أن يسلكه الأب والابن ليجد كل منهما الآخر من جديد.
أهمية النص
تنبع أهمية النص من كونه:
• جرئياً في تشريح لحظة التصدع العاطفي بين الأب والابن، وفي استحضار مشاعر القلق والوحدة.
• وثيقة وجدانية عن رغبة الطفل في معاقبة مصدر قسوته عبر القلق لا العقاب المادي.
• قراءة لعلاقة الابن بالأب في مجتمع تقليدي تُعدّ فيه القسوة جزءًا من التربية والعاطفة جزءًا من الإنكار.
• كشفًا عن هشاشة الطفولة وقدرتها على المقاومة بالفرار.
• دراسة نفسية عميقة للخوف والذنب والبحث عن العاطفة.
• نصًا يضيء الهامش الاجتماعي عبر المهمشين والبئر والسوق والحراس.
رسالة النص
القسوة لا تقتل الحبّ، لكنها تدفعه أحيانًا إلى الهروب ليعود أكثر إدراكًا لعمق الجرح.
الرسالة التي تتردد في النص بوضوح: إن الجفاء العاطفي يُولّد الفرار، وإن أشدّ العقاب هو أن يتجرّع من نحب مرارة الخوف علينا، فتنكسر على عتبته حواجز الكبرياء والقسوة.
إنها دعوة للتفاهم قبل أن يحلّ “غلس الليل” على العلاقات، ولإعادة النظر في علاقاتنا وكيف أن القسوة قد تُفقدنا أعز ما نملك.
القراءة النفسية للنص: كسر قناع القسوة
– الأب: صراع الحب والسلطة
العلاقة بين الأب والابن تتجاوز الصراع السطحي إلى حبٍّ مكبوت يرتدي قناع القسوة.
هذه القسوة ليست جوهرًا، بل قناعًا فرضته ثقافةٌ تُلزم الرجل بالسلطة وكتمان العاطفة.
لكن هروب الابن كان الزلزال الذي أسقط الأقنعة ليظهر الأب كائنًا خائفًا محبًا مذعورًا من الفقد.
– نفسية الطفل الهارب: استغاثة وجود
ما يعتمل في نفس الطفل مزيج من الخوف والظلم والكرامة المجروحة.
الفرار ليس تمرّدًا بل استغاثة مبطنة، ومحاولة لمعاقبة الأب نفسيًا عبر إثارة قلق الفقد.
يمارس الطفل استقلالًا رمزيًا، كأنه يصرخ بلا صوت: “انتبه لوجودي.. أدرك قيمتي”.
– أثر الليل: إسقاطات الخوف الداخلي
الليل في النص زمنٌ ومرآة معًا؛ تتكثف فيه إسقاطات الخوف ويغدو المسرح الخارجي امتدادًا لقلق النفس.
كل ضوء خافت يصبح أمانًا، وكل حركة بعيدة تتحول إلى ظلّ يضاعف ارتياب الطفل.
– التطهير العاطفي في الختام
يشكّل المشهد الأخير ذروة التطهير النفسي؛ حيث تلتقي مشاعر الطرفين بصمتٍ مُهيب.
ينكسر الأب أمام خوفه، ويلين الابن بعد تحقيق هدفه الرمزي.
يتحوّل الخوف إلى دفء، والندم الصامت إلى مصالحة بلا كلمات.
القراءة الاجتماعية
– قوام السلطة والقناع الأبوي
يسلط النص الضوء على سلطة اجتماعية تقدّس القسوة كقناع تربوي.
لكن الهروب يكشف هشاشتها، ويظهر أن الأب رغم سلاحه وهيئته محكوم هو الآخر بثقافة تمنع إظهار الضعف.
– المهمشة “رسلة”: عين المجتمع
تمثل “رسلة” رمزًا لليقظة الاجتماعية، فدورها لم يكن صدفة بل جزءًا من منظومة حماية غير معلنة.
تبلغ الحراس لتعيد الأزمة العائلية من داخل البيت إلى معالجة المجتمع بأسره، مؤكدة أن الوجع العائلي لا يبقى حبيس الجدران.
تحليل أدبي
1. البنية السردية
البنية قائمة على:
• سرد ذاتي بضمير المتكلم يمنح النص حرارة الاعتراف.
• تدرّج يبدأ بسبب مجهول وينتهي بكشف نفسي كبير.
• تصعيد درامي: هروب.. خوف.. مواجهة الظلام.. اكتشاف.. إنقاذ.. لقاء الأب.
• حركة مكانية واسعة تنقل السرد من الخاص إلى العام بلمحة سينمائية.
2. اللغة والأسلوب
لغة النص:
• تمزج بين السلاسة والعمق.
• تعتمد إيقاعًا داخليًا وتكرارًا موسيقيًا.
• غنية بالمفردات الحسية والصور المكثفة.
• تشبه اعترافًا روائيًا يستعيد جرحًا قديمًا.
3. الشخصيات
• الأب: قاسٍ بقدر ما هو محب، مأزوم بالموروث التربوي.
• الطفل: عنيد وهشّ، يبحث عن الحب والأمان.
• رسلة: حضور هامشي فاعل، تمثّل عين المجتمع.
• الحارسان: وسيطان رحيمان في لحظة خوف.
النقد الأدبي مكامن قوة وضعف النص
أولا مكامن قوة النص :
يتمتع نص “فرار وقت صلاة المغرب” بقوة أدبية لافتة مستمدة من عمقه النفسي والفني، تتجلى في الآتي:
* الصدق العاطفي وتوازن المشاعر: يرتكز النص على الاعتراف الشفيف بضمير المتكلم، مما يضفي عليه شرعية وصدقًا عميقًا يلامس وجدان القارئ مباشرة، جاعلاً إياه شريكًا في الهاجس والخوف. هذا البوح الغني يوازن ببراعة بين المشاعر المتضاربة؛ من خوف الطفل وقلقه الوجودي، إلى حنين الأب المكبوت وذعره من الفقد، مما يخلق توازناً فنياً ودرامياً آسراً.
* شاعرية اللغة والسرد السلس: على الرغم من طبيعة السرد الواقعية، تنساب اللغة بسلاسة عذبة وتدفق شاعري يشدّ القارئ. تزخر الجمل بتعابير بليغة واستعارات وكنايات تتدفق في النص كالنهر، مما يمزج بين الواقعية المعيشة والجمالية الأدبية دون تكلف.
* بناء المشهد الرمزي: يتميز النص بتصوير بديع للحظة الهروب في وقت صلاة المغرب؛ وهو توقيت رمزي يمزج ببراعة بين السكينة الروحية (الصلاة) والقلق الإنساني (الفرار). كما أن استخدام تفاصيل المكان المحلي (البئر، السوق، الأشجار) يمنح النص عمقًا واقعيًا ويجعل الأحداث متجذرة في بيئة حية وملموسة.
* ذروة القوة في الصمت: تكمن الذروة الفنية في الخاتمة المُتصالحَة؛ حيث لقاء الأب والابن الصامت، المُحاط بهالة من الندم الكتوم والعاطفة الحانية غير المعلنة. هذا الصمت أبلغ من كل الكلام، ويمثل الحل النفسي والروحي الذي يحرر الشخصيتين، مُعلنًا أن الحب الكاتم قد وجد طريقاً للتعبير من خلال خوف الفقد.
ثانيا مكامن ضعف النص (المحتملة) :
على الرغم من جمال النص وعمقه الوجداني، يمكن رصد بعض الملاحظات الفنية التي قد تُعدّ مكامن ضعف محتملة أو نقاطاً تحتاج إلى مزيد من التكثيف:
• في الاستهلال، بدت دوافع الهروب مطوّلة بعض الشيء، إذ تكررت الإشارة إلى قسوة الأب و الرغبة في معاقبته، بما كان يمكن اختزاله لصالح تكثيف الوقع العاطفي للمشهد.
• يفتتح الكاتب بالقول: “لم أعد أذكر كثيراً منها”، ثم يتابع: “لم أعد أذكر أسبابها”. هذا الغموض، على الرغم من انسجامه مع فكرة تراكم الأسباب وتداخلها، يترك القارئ متسائلًا عن الشرارة الدقيقة التي جعلت الطفل يفرّ تحديدًا عند وقت المغرب. كان من الممكن إتاحة لمحة أو إيحاء أعمق يروي عطش السؤال.
• أما الشخصيات المساندة وخاصة الحارسان والمرأة المهمّشة التي نهض دورها في الإنقاذ فقد مرّت كظلالٍ عابرة. لم تُستثمر بما يكفي لمنح الحكاية بعدًا اجتماعيًا أو إنسانيًا أوسع، خصوصًا أن حضورهم كان مؤثّرًا في مسار الحدث
مقاربات
إن نص “فرار وقت صلاة المغرب” يقف على أرضية مشتركة مع العديد من الأعمال الأدبية، لكنه يحافظ على نكهته الخاصة.
– فيما يتعلق بأدب السيرة الممزوج بالتخييل، نجد تشابهاً مع أسلوب أمين معلوف من حيث اعتماد اللغة الشاعرة التي تمزج السرد بالمجاز.
لكن الاختلاف الأبرز يكمن في أن كاتبنا هنا يختار الاعتراف المباشر والوثيقة الوجدانية الخالصة التي تنبع من تجربة شخصية محلية عميقة، متجنباً البناء الرمزي المعقد، ليُقدم صدقاً لا ينافسه الخيال المتعمد.
– وعند مقارنته بعمالقة السيرة، يتداعى إلى الذهن فوراً عمل طه حسين، “الأيام”، فكلاهما يروي معاناة الطفولة تحت وطأة القسوة وغياب اللين.
بيد أن نص حاشد يركز تركيزاً كثيفاً على الزاوية العاطفية الحادَّة، مشرحاً العلاقة الملتهبة بين الأب والابن في ليلة واحدة، بينما تميل “الأيام” لتصوير المعاناة في إطار اجتماعي وتاريخي أوسع.
– كما يمكن أن نجد وجهاً للتشابه مع أدب نجيب محفوظ، لا سيما في رواية “يوم قُتل الزعيم” من حيث التوظيف البارع للأماكن الشعبية والتفاصيل المحلية كعنصر حاسم في دفع السرد.
وإذا ما وضعناه في كفة “اللص والكلاب”، فكلاهما يعرض هروباً من واقع مؤلم، لكن هروب حاشد يظل أكثر عفوية وقلقاً وجودياً، فهو فرار طفلٍ لا مجرم، ينبع من صراع نفسي بحت.
– إن هذا النص، في عمقه الروحي، يتشابه مع أعمال أدب السيرة والروايات التي تلامس غربة الروح والتمرد الداخلي، كما نجد في بعض ملامح أدب جبران خليل جبران. فالهروب هنا هو صرخة طفل لإثبات الوجود والتخلص من قيد القسوة.
لكن النص يحفر لنفسه مساراً مختلفاً من خلال النهاية المتصالحة؛ فهو ينأى بنفسه عن الأعمال التي تفرض القطيعة أو الفقد الدائم، ليقدم تناغماً روحياً وندماً متبادلاً يمنح القصة دفئاً خاصاً يغيب عن نصوص النقد الاجتماعي القاسية. وتتجلى قوته أيضاً في اعتماده على صمت الشخصيات للتعبير عن أعمق العواطف، حيث يصبح الصمت “كثيفاً وحاضراً” ومهيباً، كاشفاً ندمهما المكتوم وما عجزت عنه الألفاظ.
الخاتمة
«فرار وقت صلاة المغرب» نصٌّ مفتوح على الذاكرة، كأنه حوار طويل مؤجَّل بين أبٍ وابنه، وبين الطفل والرجل الذي أصبحه لاحقًا.
يقرأ القسوة بوصفها ظلًا للحب، والهروب بوصفه بحثًا عن حضن، والليل بوصفه مرآة للنفس.
إنه نصّ يحمل قدرة نادرة على استدعاء طفولتنا نحن، وعلى لمس تلك اللحظات التي اختبرنا فيها الخوف أو القسوة أو الحاجة إلى أن يُرى وجودنا.
في النهاية، النص ليس هروبًا من الأب، بل رحلة إلى الذات بحثًا عن السلام والغفران.
إنه أثر يبقى في القلب كالندى: يذكّر بأن الحب قد يختبئ تحت غيوم القسوة، لكنه يظل حاضرًا كشمس تنتظر الغروب لتشرق من جديد
نص “فرار وقت صلاة المغرب”
أحمد سيف حاشد
كانت تتكاثر الأسباب التي تدفعني للفرار من أبي.. لم أعد أذكر كثيراً منها، ولكن في جلّها ترجع إلى شدته وقسوته، وما يزيدها تعقيداً ما يتبعها من انفعالات، أو ردود أفعال، تؤدّي إلى مزيدٍ من تفاقم المشكلة، وإفساد الحال، ومعه “تزيد الطين بله”.
أحياناً لا يخلو واحد منّا أو كلانا من ارتكاب حماقة في وجه الآخر، ربما بسبب ضغوطات الحياة، أو التسرع على حساب التريث والأناة، أو ضيق صدر أحدنا بالآخر، أو بسبب لحظة حرجة أشتد ضيقها علينا، وغيرها من الأسباب، حتّى أجد نفسي في بعض الأحيان أتخذ قراري بمغامرة أو مقامرة، لا تخلو من عناد، وعدم اكتراث بنتائجه وتبعاته.
في الواقعة التي أنا بصددها هنا، لم أعد أذكر أسبابها.. ما أذكره هو أن هروبي كان وقت صلاة المغرب، حيث قررتُ الفرار، دون أن أعرف إلى أين..!! وأين سأبيت ليلتي الأولى؟! وأين سينتهي بي الرحال؟!! كان الأهم في تفكيري هو إفلاتي أولاً من قبضة أبي، والحيلولة دون اللحاق بي حال فراري، وأن لا تدركني قبضته، ثم بعدها “لكل حادث حديث”.
لم يعد منزلا جدي وأخوالي مَلاَذَيْنِ أركن إليهما، فأبي سوف يستعيدني بسهولة من غير موافقتي ورضاي، وسينطبق على حالي المثل: “كأنك يا بو زيد ما غزيت”. كما أنني صرتُ حساساً حيال خيار اللجوء إليهم بعد تكرار، ولا أريد أن اتسبب لهم بحرج أو امتعاض، وقد بتُّ أشعر بثقلي عليهم، وربما تسلل شيء من إحساس إلى نفسي لا يخلو من فتور أهل الدار حال قدومي إليهم هارباً من أبي، وفي كل حال بتُّ أدرك أن والدي سوف يصرُّ على استعادتي منهم دون تأخير، وربما أعود معتولاً بأذُني كما حدث في مرة سابقة.
إضافة إلى هذا وذاك كنت أريد أبي أن يبحث عنّي بمشقّة أكبر دون أن يجدني، أو يعرف لي وجهة أو مستقر.. أردتُ معاقبته بطريقة ما، وفي حدود ما هو ممكن ومتاح.. أريده أن يعيش بعضاً من القلق والشعور بالندم إن استطعت، ولن يكون هذا إلا بفرار إلى مكانٍ مختلف، عمّا اعتدتُ عليه.. لا أريد أن أبي يعرف وجهتي أو إلى أين سأذهب، وأين سيكون المبيت.. أريد أن أضع في تفكيره احتمالية أن تؤدّي قسوته إلى فقداني، أو إلى مجهول أو مكروه لا يعرفه.
***
هربتُ في وقت كان فيه غلس الليل قادماً، وسيلقي سواده بعد قليل على الطرقات والأمكنة، دون أن أعلم أين سأبيت ليلتي الأولى، بعيداً عن جميع الأهل والأمكنة التي اعتدتها فيما سبق، أو يفترض أن أنتهي إليها.. صرتُ أركض وأمشي، وأهيم على وجهي، دون أن أعلم إلى أين!!
بدأت رحلة هروبي بإفلاتي أولاً من قبضة أبي.. توقعتُ أن يدركني بحماره.. عَدَوْتُ كثيراً لأبتعد عنه.. كان لهاثي يسبق وقع أقدامي على الأرض.. نبضاتي تثب من قلبي الذي يكاد هو الأخر أن يقع منّي في الطريق.. صدري لم يعد يتسع لسرعة كدت أهلك بها نفسي.. كدتُ أقع من طولي وأنا اركض بسرعة تقطع أنفاسي.. أحسستُ أن نفسي تكاد تغادر جسدي وتصعد دوني إلى السماء إن ظللتُ بالركض على ذلك النحو الذي بدأته.. وبعد مشوار من الركض السريع ألتفت إلى خلفي، واطمأننتُ أنني لم أرَ أبي وحماره.. اطمأننت قليلاً، وأبطأتُ من سرعتي بعد أن كدتُ أقع، وكادت قواي تخور.. تبعتها مشياً على السريع حتّى وصلتُ إلى سوق الخميس.
***
وبعد السوق تعدّيتُ قليلا “بئر نعمان”.. هناك خطرتَ لي فكرة لعلّي أحتاجها، أو استعين بها على مجهول حين اللزوم؛ وملخص الفكرة أن لا ابعدُ كثيراً عن البئر.. أخبرتني نفسي أن آنس إلى هذا المكان الذي سوف أبيت فيه للصباح. و”الصباح رباح” كما جاء في المثل، و “من مشنقة إلى مشنقة فرج” يكتبه القدر، وستفرج بعد ليل وإن طال.. سيكون المبيت هنا أكثر أماناً من غيره، وسأكون أقرب لأي غوث أو نجدة.
لن أبتعد عن البئر كثيراً، لاسيما وأن قرانا تعيش نزافاً يشتد، بعد أن جفَّت آبارها، والماء في هذه البئر لا بأس به، وفي الليل أوفر، والنسوة تتقاطر عليه من بعيد وقريب، وسوف يستمرَّنَّ دون انقطاع إلى الفجر، جلباً للماء ذهاباً وإياباً.
مبيتي هنا سيجعل بوسعي أن أرى الضوء حول البئر بين فانوس وكشّاف، من غلس الليل حتّى مطلع الفجر، كما أن زحام النسوة طوال الليل لن يكلُّ ولن يفتر، وبمسافة قريبة يوجد هناك أيضاً دكان وطاحون نعمان، وعليه حرّاس يرابطون ليلاً في المكان.. قلتُ لنفسي وأنا أحاول تطمينها: هنا المبيت آمناً أو ممكناً، وخياره أفضل من أي مكان آخر، ربما يكون حافلاً بالاحتمالات المُفزعة، أو يكون وراداً بمجهول.
اخترتُ مكاني في زاوية من الوادي، ومعه اخترتُ أن أوجّه وجهي إلى البئر لأرى ما أطمئن إليه، ويمنحني قدرا من السكينة والدعة، فيما ظهري أسندته نحو بيوت المهمشين في الاتجاه المقابل بعد منعطف، وعلى مسافة قريبة في يساري شجرة “حُمرَ” وارفة ومعمّرة، ربما أهرع إليها، و أتسلقها لداعٍ أو ضرورة، أما يميني فمسنود إلى جبل، بإمكاني تسلقه إن لزم الحال. بإمكاني هنا أن أنام جوار شجرة “الثَّاب” بعد تعب اشتد، وإنهاك ضرب مفاصلي، وهد معه حيلي وقواي.
وجدتُ تحت شجرة “الثاب” أوراقاً نافلة ويابسة كثيرة، تحدث صوتاً واضحاً وجلياً عندما تتحرك أو تداس بالأقدام، وقبل أن أذهب في النعاس إلى أبعد منه، سمعتُ ما يثير فزعي.. لعلّها سحالٍ أو زواحف أخرى، ومن يدري ربما ثعابين.. تنامت واشتدت مخاوفي من كل اتجاه.. تكاثر ما أسمعه، وبعضه صار منّي يقترب.. تغوَّل ارتيابي وكثرت المحاذير.. انزحتُ من المكان قليلاً إلى فوق جدار قريب معمور، واخترتُ عليه مرقدي بعد إصلاح، وتمهيد حذر.
شاهدتُ في الطريق بعيداً كتلة داكنة أكثر سواداً من الليل، ثم تبدّى لي ما يشبهُ شبحاً أسود صرتُ أسمع خطاه بوضوح.. كلمّا أقترب من مكاني رأيته يكبر.. أسمع دعسه على الحصى وهو يقترب.. بدأ تخميني يميل إلى أنها امرأة أو جنية وليس رجل.. من ملبسها بدا لي كذلك.. حبست أنفاسي فيما كانت ضربات قلبي ترتفع.. مالت أكثر نحو المكان الذي كنتُ راقداً فيه.. حاولتُ أتراجع وانزاح قليلاً نحو الجبل.. يبدو أنّها رمقت حركتي، ولم يخنُها سمعها.. بدت لي جريئة وشجاعة، ولعل فضولها دفعها لتستكشف الأمر أكثر، وقد أثرتُ لديها مزيداً من الغرابة.
وفيما أنا حابس أنفاسي، وأحاول أبدو مخموداً دون حراك، اقتربت منّي أكثر لتعرف ما هو غير معتاد.. اقتربت حتّى بتًّ منها على مدة يد واحدة، وقد أدرَكَتْ أنني طفل، وأدركتُ أنا أنها امرأة.
بادرتني بالسؤال: موه تعمل هنا؟!
أحسستُ أنني سبق أن سمعتُ صوتها.. لقد كان الصوت مألوفاً ومميزاً، وساحباً بلسان ثقيل.. رأيتها تتمعنُّني بعجب وغرابة.
اجبتها: أنتظر أُمّي تكمّل.. أمي فوق البئر تسارب الماء.
عرفتني وقالت: أنت ابن سيف حاشد.
أنا أيضاً عرفتها.. إنها “رسلة” شابه عشرينية على الأرجح، مهمّشة وطيبة وودودة، كانت أحياناً ترتاد دكان أبي.
أجبتها بالاعتراف أنني ابن سيف حاشد.
تفاجأت بوجودي في ذلك المكان المثير للغرابة.. لم ينطل عليها عذري، وما أوردته لها من ادِّعاء.. طلبت هي أن أرافقها إلى أمّي الذي أدّعيتُ أنها فوق البئر، لكنّي امتنعتُ عن تلبية طلبها، وأمعنتُ في الرفض، وقد بدا لي أن “حبل الكذب قصير”، وأن ذهابي معها سيكشف كذبي وزيف ادعائي على مشهد من نساء كثار.
ملأها الشك والارتياب بأمري، وازداد لديها فضول المعرفة حافزاً، وزاد على الفضول فضول.. لم ينطلِ عليها أنني أنتظر أمّي في مكان يبعد عن البئر مسافة لا مبرر لها، وأكثر منه أن المكان الذي أنا فيه يعاكس اتجاه مجيء أمي وإيابها على فرض وجودها فوق البئر.
لم تستسغ عذري بأي وجه، وهي تقلبه بعجب ظاهر وباطن.. بدأ عذري سخيفاً وأوهن من الوهن، إنه عذر غير مستساغ وغير مقبول.. غادرتني وذهبت بمفردها للتحقق والتأكد عمّا إذا كانت أمّي فعلاً موجودة فوق البئر أم لا، ولكنّها لم تجدها، ولم تجد لها خبراً أو أثراً، والنتيجة صارت مزيداً من الغرابة والعجب المضاعف.. هرعتُ بعدها إلى “دكان نعمان” لتبلغ حراسته بالأمر، وبما وقع.
***
كان “دكان نعمان” يعج بالبضائع التي يستوردها من السوق الحُرّة في عدن.. كانت تلك البضائع رخيصة ومربحة ومعفيّة من الضرائب.. وكان للدكان حرّاس يقطين.
أخبرتهم “رسلة” أنها وجدتني في حالة غريبة.. قالت لهم إنني كذبتُ عليها، وأن في الأمر سراً أو شيئاً لا تعلمه.. أرشدتهم إلى مكاني دون أن تتقدمهم أو ترافقهم.. وصفت لهم مكاني بوضوح دون غبش أو التباس.
طار النوم قبل مجيئه.. غادرني نعاسي نافراً منّي دون عودة.. فقدتُ السيطرة على نعاسي ونوم كاد يأتي.. مرّ بعض من الوقت الثقيل، فيما توجساتي كانت داخلي تموج وتضطرب.. تحتمل هذا وذاك دون أن تستقر.. أترقبُ ما سيأتي من غامض أو جديد.
اعتراني قلق ظلّ يكبر ويزداد كلّما مرّ قليلاً من الوقت.. كبر السؤال لديّ عمّا تفكر به “رسلة” وما يمكن أن تفعله..!! الأكيد أنها ستفعل شيئاً ولكنّي لا أعرفه.. أحاطني غموضها بمضي الوقت بقلق مضاعف.. كيف ستتصرف بعد الذي حدث..!! الأكيد أنها لن تترك الأمر على رسلة، ولن تطلق الحبل على غاربه.
شاهدتُ سواداً متكوَّماً قادماً من بعيد، ومن غير اتجاه البئر.. رأيتُ ما يشبه الشبحين يزيدان اقتراباً من مكاني، فيما الذعر يكتظ داخلي، وينتشر في أوصالي ويستنفر أطرافي.. صرتُ أهم بالهرب، وكدتُ أن أهرب بالفعل، غير أن مناداة أحدهم باسمي، جعلني أميز صاحبه وأعرفه.. إنه سعيد عبدالولي، أحد حراس “دكان نعمان”.. صوته منحني شعوراً بالأمان، وربما بالمساعدة أيضاً.. شاهدتُ وعرفتُ أيضاً مُرافقه.. شخص اسمه “موسى” على اسم نبي الله.
منحاني قدراً من الاطمئنان والهدوء.. سألاني بلطف ودود.. اعترفتُ لهما، وأخبرتهما أنني هارب من أبي.. أقنعاني بأن أعود معهما إلى أبي.. طمأناني ومنحالي ما يكفي من الثقة والشعور بالأمان.. ووعداني أن لا يطالني من أبي عقاباً أو تعنيفاً أو دونه.. ووعداني أنهما سيتوليان مع أبي الأمر كلّه.. وعزز هذا أنني كنتُ أعرف أن أبي يحترمهما، وأغلب الظن لن يخلف لهما شوراً ولا قولا.
رافقتهما للعودة بي إلى أبي.. كان سعيد يمشي في المقدِّمة، وانا بعده، يلينا موسى راشد.. بَدَونا كموكب صغير يسير بصمت في لجة الليل وكنفه.. وفي منتصف الطريق ومنعطف السير بزاوية تكاد أن تكون قائمة، تقابلنا فجأة بأبي، دون أن نتوقع مجيئه أو مصادفته في الطريق.. تقابلنا جميعاً وجهاً لوجه.. رأيتُ أبي بطلَّته الفارعة، وسلاحه الشخصي.. سمعتُ أنفاسه ولهاثه، وكأنه كان يحمل ويكر في وغى حرب أو حميّة معركة.
لا أعرف كيف أتى أبي، وإلى أين كان يتجه، والمكان الذي كان يقصده.. أحسستُ أنه يسير بتيه دون أن يعلم أو يقصد مكاناً محدداً بذاته.. رأيت أبي هذه المرة على غير عادته.. لم يستطع تصنع مُكابرته، أو تقمص وإعلان القسوة المعهود بها.. القسوة المعاندة التي درج عليها، ويرفض أن يتنازل عنها حتّى وإن كانت عاطفته نحوي تموج داخله.
لا أدري سبب هدوئه هذه المرة نحوي، وعدم استثارته حالما كنت أتطلّع إليه..؟!! هل هي سكينة الناس، وتجنب إزعاجهم، وإثارة فضولهم في هذا الوقت من الليل؟!! أم هو الاستفادة مما يوفره الليل من غطاء لمداراة تنازله عن كبريائه وقسوته أمام الناس؟! أم هلع أُمّي وجنونها وزنينها عليه، أم أن أبي تذكر رؤيا كان قد نسِيتها، وفيها ما ينبئه بخطر سوف يصيب ولده؟! أو أن السبب هو احتمال فقدان قد يستمر، وخوفه من مجهول قد يصيبني فيما يكره؟!!
أحسستُ أن أبي كان يمشي مثلي ويهيم على وجهه دون أن يعرف هو الآخر إلى أين سيذهب، ربما كثرت مخاوفه بعد أن تأكد من بيت جدّي وأخوالي أنني لست موجوداً لديهم، وربّما أخبروه أنهم شاهدوني راكضاً في الوادي، ولكنهم لا يعلمون إلى أين..!! أحسستُ بهلعه وخوفه، ومعها حميمية لا يتمزّق عراها.
رأيتهم ينزاحون قليلاً عن الطريق وتركوني لوحدي.. سمعتهما يتحدثان مع أبي بصوت خفيض، ثم عادا إليّ، وطمأناني أن الأمور سارت على ما يرام.. أحسستُ بعاطفة جارفة من أبي ترغمه على التعاطي معي بهدوء غير معهود.. أنا أيضاً أحسستُ بعاطفة تجتاحني نحوه.. احتدم بيننا ندم كبير غير معلن، وجيش من العواطف الكتومة التي نداريها عن بعضنا حتّى لا تنكشف مكامن ضعفنا المُتخيّلة.
اجتاحني احساس غامر بالمودة وهو أيضاً يبادلني الإحساس والمشاعر نفسها إن لم يكن هو السبّاق لها لا أنا.. ربُّما تشاركنا معاً الندم والخوف من مستقبل قد يقود إلى كلفة باهظة.
أحسستُ بمكانة رفيعة في وجدان أبي.. تفاهم الجميع.. سلّماني الرجلان إلى أبي.. استلمني بليونة ورفق وعاطفة حانية حاول كتمانها عنّي، ولكنّي أحسستُ بها دافئة من لحظات صمته التي كانت كثيفة وحاضرة.
كان يسير أمامي وأنا أسير وراءه بانقياد وعاطفة وطاعة.. سرتُ بعده دون أن ينبس أحدنا للأخر ببنت شفه. لكن تناغم روحي سرى فينا، وجعل كل منّا يقرأ مشاعر الآخر وأحاسيسه بطريقة لم نعهدها في مشوار خلافاتنا التي لم تنتهِ يوماً إلا لتبدأ من جديد.
***