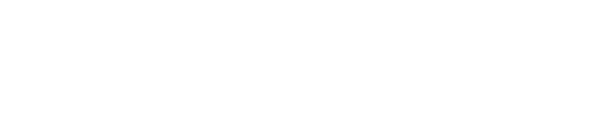قراءة تحليلية لنص “هروب وعودة” لـ” أحمد سيف حاشد”

برلماني يمني
تم إعداد التحليل ادناه بالذكاء الاصطناعي، لنص “هروب وعودة” المنشور في كتاب “فضاء لا يتسع لطائر” والذي يستعيد فيه الحقوقي والكاتب اليمني أحمد سيف حاشد طفولته بين خوف الأب وأمان دار الجد، حيث يصبح الهروب وسيلة نجاة وصناعة وعي مبكر بالحرية.
النص يوازن بين المأساة الفردية والوطنية، ويحوّل المكان والزمن والشخصيات إلى فاعلين في السرد. لغة شاعرية وصور حية تربط بين الخوف والخيبة، وتقدم نقدًا ضمنيًا للسلطة الأسرية والوطنية. في النهاية، النص مرآة لتجربة الطفل الباحث عن الأمان في عالم غائب فيه القانون والنظام.
إضاءة
“جنوب اليوم لم يعد كما كان.. لا مجير هنا ولا مجير هناك”. الجنوب هو الأمان المفقود، وكل الأمكنة جحيم في جحيم أكبر من كل طفولة خائفة.. الأمس مليء بالخوف و اليوم مليء بالخيبة.. عندما تنهار الأوطان يحدث الفقدان؛ فلا دولة ولا دستور ولا أمان ولا نظام..
ملخص النص
النص “هروب وعودة!” هو قطعة سردية ذاتية عميقة، يسترجع فيها الكاتبُ أحمد سيف حاشد لحظات مصيرية من طفولته، ناقلًا إيانا إلى دهاليز ذاكرة مكلومة، حيث يُصبح الهروب المتكرر ملاذًا ونجاة من قسوة الأب وعنفه.
يروي النص قصة الهروب الأول إلى “دار الشناغب”، بيت الجد (والد الأم)، الذي كان يمثل الحصن والملاذ الآمن للأم في أوقات حنقها. ويصف الكاتب شخصية الجد الزاهدة والمسالمة، الذي دفع حياته ثمنًا لصراعات سياسية لم يكن طرفًا فيها، إذ ذهب للعلاج ولم يعد.
تتصاعد الأحداث مع الهروب الثاني؛ إذ تتحول تجربة الطفولة المليئة بالتوتر والخوف إلى مواجهة وجودية مع الأب الغاضب، الذي يصل مُمتطيًا حماره، محمّلًا ببندقيته وغيظه. وفي ظل هذا الخطر، يتخذ الطفل المذعور قرارًا جريئًا باللجوء إلى الجبل، متجهًا نحو حدود دولة جنوب اليمن، باحثًا عن دولة ونظام يحميه من عنف الأب.
هنا، يتدخل الزمن النسائي (الأم، الخالة مريم، النسوة)، مُشكلًا قوة موازية لعنف الأب، حيث تبدأ عملية تفاوض مُضنية تنجح في إيقاف النار المحتملة. يعود الطفل في “موكب حماية” يحيط به، لكن الأب ينفجر بالغضب في الطريق، وينكث وعده مُصوِّبًا بندقيته مرة أخرى نحو ابنه. إلا أن أجساد من يحيط به تحول دون إلحاق الأذى بالطفل، ويتراجع الأب مُجبرًا ويعيد ابنه إلى منزله القديم.
أهمية النص
تتجاوز أهمية هذا النص حدود السرد الشخصي لتلامس قضايا جوهرية على مستويات عدة، تتجلى فيما يلي:
الكشف عن تشريح السلطة والقهر الأسري
تكمن القيمة الجوهرية للنص في كونه مرآة تكشف صراع السلطة الأبوية والقهر الطفولي ضمن بيئة ريفية يمنية، قاسية التربية، عاشقة للجبال، ومتناقضة في مشاعرها.
النص ليس مجرد سيرة عابرة، بل هو توثيق أدبي عميق لتأثير القسوة الأسرية على نفسية الطفل، وكيف يمكن لـ الخوف الوجودي أن يدفع كائنًا صغيرًا للبحث عن “دولة” أو “نظام” يحميه من “جور أبيه”.
النص لوحة تلتقط أنفاس مكان وزمان مضى، ووثيقة عن طفولة في مجتمع تسوده الثقافة الأبوية، حيث تتحول العلاقات الأسرية إلى ساحة حرب مصغرة.
بين المأساة الفردية والوطنية
الأهم من ذلك، أن النص يرتفع بالمأساة الشخصية ليربطها بالمأساة الوطنية. فـ “الجنوب” الذي كان ملاذًا متخيلاً للطفل الباحث عن نظام في الماضي، يتحول في زمن السرد الحاضر إلى وهم آخر، في وطنٍ تمزقه الصراعات وأصبح كله “جحيماً في جحيم”.
النص بذلك يصبح مرآة لانكسار الفردي في الجماعي، والخاص في العام، مُقدمًا نقدًا ضمنيًا لحالة الأمان المفقود على مستوى الوطن.
ثنائية السلطة والعاطفة
يُضيء النص ببراعة العلاقة المعقدة بين السلطة والعاطفة داخل الأسرة. فالأب هنا لا يُقدَّم كشرير مطلق؛ بل هو رجل تحكمه الأعراف الصارمة، والسلطة الذكورية، والنفسية الفوارة، مما يُفقده الرهافة الأبوية ويُحوّله إلى مصدر تهديد.
في المقابل، تحضر المرأة (الأم، الخالة، النسوة) كقوة مضادة وفاعلة، فهي الملاذ والوسيط، وحائط صدّ جسدي وعاطفي، وقوة حماية غير مُعلنة توازن عنف السلطة الأبوية.
رسائل النص
تتعدد رسائل النص وتتجاوز السرد الذاتي لتصبح صدى لقضايا وجودية، تتمحور حول الأمان المفقود والوعي الناشئ:
الخيبة الوطنية
الرسالة الأكثر إيلاماً هي الربط العضوي بين القهر الفردي وانهيار الأوطان. تتجلى هذه الرسالة في تساؤل الكاتب الموجع:
“هل يشبه اليوم الأمس؟!
والإجابة القاسية التي تختصر خيبة جيل بأكمله:
“جنوب اليوم لم يعد كما كان.. لا مجير هنا ولا مجير هناك”.
نقد للوطن الممزق
يؤكد النص أن الذاكرة لا تنجو من زمانها، بل تعود لتفسر الحاضر. هذا الربط المؤثر يقدم نقداً مُراً: فكما أن الأب عاجز عن فهم أبويته الحقيقية، أصبح الوطن عاجزاً عن توفير حماية أو كرامة لمواطنيه.
تآكل الأمان
هذه الإجابة تُرسل رسالة صارخة بأن غياب الأمان الفردي يتوازى مع غياب الأمان الوطني، وأن كل الأمكنة قد تحوّلت إلى جحيم أكبر من كل طفولة خائفة.
ولادة وعي الحرية
تتضمن الرسالة دعوة صادقة لنبذ العنف الأسري وتفهم هشاشة الروح الطفولية، مؤكدة أن الخوف هو الشعلة الأولى للبحث عن العدل.
الخوف يصنع الحرية
يصور النص ببراعة كيف يتحول الأب من مصدر أمان إلى مصدر رعب، وكيف يختزل الطفل عالمه كله في معادلة واحدة: النجاة. فالطفل لم يهرب من شخص، بل هرب من التهديد المُحدق، وهذا الهروب القسري هو أول خطوة في صناعة وعي مبكر بالحرية والبحث عن العدل.
السلطة المنعكسة
على المستوى الاجتماعي، يحمل النص دلالة قوية: حين تغيب الدولة أو تضعف قيمها، يتحول الأب إلى سلطة مُطلقة وغاشمة. هذا التصوير ينير كيف يختزل الطفل العالم كله في سلطة الأب، ويُظهر كيف أن غياب الرهافة الأبوية هي انعكاس مباشر لغياب القانون والنظام في المجتمع الأكبر.
قراءة نقدية
البنية السردية
يتميز النص بالسلاسة والصدق العاري، بلغة سهلة ممتنعة، تصل مباشرة إلى القلب. ويتجلى جماله في التصوير البصري الحي، وهذا الأسلوب يكتسب شاعريته من حِدّة المشاعر الكامنة فيه، فكل كلمة مُشبعة بعاطفة قوية من خوف، وغيظ، وتوجس، وندم.
يقوم النص على الاسترجاع حيث ينقل الراوي البالغ تجربة الطفل بحساسية مزدوجة: براءة الطفل ورهافة الراوي الذي يفكك الأحداث لاحقاً.
وهذا يخلق توتراً درامياً رائعاً، حيث نعيش رحلة الخوف كما عاشها الطفل. سرد ذاتي رجعي، يربط بين لحظة الطفولة ولحظة الكتابة الراهنة، ليخلق حواراً بين زمنين:
زمن يهرب فيه الطفل من بندقية الأب، وزمن يهرب فيه الوطن من بندقية السلطة.
البناء متدرج، يبدأ بوصف المكان، ثم يشتدّ بالحدث، ثم يتصاعد نحو الذروة، ثم يعود تدريجيًا إلى الهدوء والصلح. هذا الانسياب يعطي النص إيقاعاً قصصياً متماسكاً.
اللغة
لغة النص امتداد لأسلوب الكاتب المعروف:
شاعرية بلا تزويق،
وصف دقيق بلا ترهل،
صيغ مشبعة بالحسّ المكاني والوجداني.
كلمات تحمل في بساطتها كل مأساة الطفولة الباحثة عن نظام ودولة وحرية.
نقاط القوة والضعف في النص
نقاط القوة
1 – السلاسة والصدق العاري: لغة سهلة ممتنعة، تخلو من التعقيد، وتصل مباشرة إلى القلب.
2 – السرد العاطفي الرصين: لا إفراط في البكاء، ولا جفاف في المشاعر.
3 – التوظيف العميق للمكان كفاعل سردي.
4 – الصراع الداخلي والخارجي كلاهما حاضر: خوف الطفل وغضب الأب.
5 – التوازي بين الطفولة والسياسة بذكاء غير مباشر.
6 – اللغة الشاعرية الواضحة التي تبني الصور دون افتعال.
* إجمالا يمكن القول : اللغة شاعرية حية تستخدم الاستعارات والكنايات ببراعة، والإيقاع السردي يشبه تردد أنفاس طفل خائف. والوصف التشكيلي يمتاز بقدرة مذهلة على رسم المشاهد، وقدرة لافتة في الربط العضوي بين الشخصي والوطني وعلى نحو يرفع النص من سيرة ذاتية إلى تأمل وجودي في معنى الوطن والانتماء.
نقاط الضعف
هي نقاط ليست ضعفاً بنيوياً، بل مناطق يُمكن تعميقها فنياً:
* الإطالة في وصف بعض التفاصيل المكانية قد تُثقل على قارئ غير مُلِمّ بالبيئة الجغرافية.
* النهاية السريعة مقارنة بكثافة الذروة؛ كان يمكن إبراز أثر التجربة على الراوي لاحقاً بشكل أوسع.
* الحضور الخافت للأم رغم أنها حجر الزاوية في التجربة؛ كان يمكن منحها ظلالاً أعمق.
تحليل الشخصيات وتشابك العلاقات
تتحول الأمكنة والشخصيات في هذا السرد إلى كيانات حية تجعلك تعيش كثيراً من تفاصيلها.
* الراوي/الطفل (المؤلف): شخصية مرهفة الحس، غارقة في الخوف لكنها تملك إرادة البقاء. قرار الهروب بمفرده قرار مصيري يكشف عن نضج مبكر. الطفل يمثل الوعي الباحث عن العدل.. الطفل شديد الملاحظة عميق التأثر، يتخذ قرارات مصيرية في لحظات ضيق. هروبه ليس مجرد نزوة، بل قرار عقلاني يحمل بُعداً سياسياً مبكراً (اللجوء لدولة الجنوب بحثاً عن الحماية والنظام).
* الأب: نموذج السلطة الذكورية.. قوة متوترة، مخنوقة بالرجولة التقليدية.. العنف الذي يخضع في النهاية لـ سلطة الجمع والعهد المقطوع أمام الناس.. هنا الرواية لا تدينه إدانة مطلقة؛ بل تضيء ما هو إنساني فيه: تردده.. وعوده المجبورة.. وسخطه الذي ينهزم أمام الناس والنسوة.. رغبته في الحفاظ على ماء الوجه الاجتماعي.
* الخالـة مريم: الوسيط البطل والمُحرِّك الفعال. بـ “شخصيتها الأنثوية القوية… صارمة وحازمة ومفاوضة ناجحة”.
* الجد: يمثل الرمز المسالم والزاهد الذي لا يعبأ بالسياسة، ومع ذلك يُقتل بسببها.. هو النقيض الأبوي للأب القاسي، وهو ماضٍ كريم ضاع في غبار القسوة.. السلام الروحي والزهد في عالم مليء بالصراعات السياسية.. جبهة تحرير وجبهة قومية.
* البندقية: رمز السلطة التي يستعين بها الأب لتهديد وفرض وإخضاع ولده المتمرد على سلطته.
توظيف المكان كشخصية فاعلة
المكان: يتحول من مجرد خلفية إلى شخصية فاعلة.
* دار الشناغب: رمز الأمان والجذور والأمومة.. المكان يحمي ويهدد في آن.
إنه الحصن – الوطن – الذاكرة – الصندوق الأسود.
* الجبال والوادي: تمثل العقبات النفسية والمادية.. وعورة الطريق إلى الحرية، وفي الوقت نفسه ملجأ للاختباء.
* الحدود: ذلك الحلم البعيد، الخط الفاصل بين العذاب والخلاص، الذي يتحول في الحاضر إلى وهم.
* الزمان: يتنقل النص ببراعة بين الأمس المليء بالخوف (الهروب الطفولي) و اليوم المليء بالخيبة (التعليق السياسي الحالي)، رابطاً بينهما بخيط الألم المشترك: ضياع الأمان.
البعد السياسي
العمق الفكري في النص، يتألق في المقارنة السياسية المؤثرة، حيث يربط النص بعبقرية بين القهر الأسري وانعدام الأمن الوطني (“لا مجير هنا ولا مجير هناك”)، متنقلًا ببراعة بين الأمس المليء بالخوف و اليوم المليء بالخيبة.
لقد تضمن النص إدراج نقداً سياسياً مريراً من الذاتي إلى العام وهي ليست قفزة مفتعلة، بل نابعة من شرخ أصيل بين المواطن والدولة في تاريخ اليمن الحديث.
مقاربات مع كتّاب ومفكرين
هذا النص ينتمي لتيار السرد الذاتي النقدي الذي يتجاوز حدود الحكاية الشخصية ليصبح صوتاً جماعياً.
* مع “الخبز الحافي” لمحمد شكري تشابه في تصوير قسوة الأب والعنف الأسري كمعطى أساسي في تشكيل وعي الطفل.
لكن شكري أكثر قسوة وواقعية صادمة، بينما نص حاشد “هروب وعودة” يمتلك حساسية شاعرية وحنيناً حتى في لحظات الألم.
* مع “شرق المتوسط” لعبد الرحمن منيف تشابه في ربط استبداد الأسرة الصغيرة باستبداد النظام السياسي (السلطة الأبوية). كلاهما يقدم نقداً للمجتمع من خلال تشريح العلاقات الداخلية.
* مع أدب الطاهر بن جلون تشابه في استكشاف عوالم الطفولة المعذبة والعلاقة المضطربة مع الأب. لكن بن جلون غالباً ما يغوص أكثر في البعد النفسي-التحليلي، بينما حاشد يقدم اللوحة بتلقائية السارد الذي يعيش اللحظة.
* مع عبد الرحمن منيف – «شرق المتوسط» التشابه: نقد السلطة والخوف والبحث عن كيان يحمي الفرد.
الاختلاف: منيف يتناول القمع السياسي المباشر، بينما نص حاشد يقدّم قمعاً أسرياً يتحول إلى استعارة سياسية.
* يتشابه النص مع أدب طه حسين في استعادة الماضي بمرارة ونقد للبيئة، مع إعلاء قيمة الوعي الطفولي.. النص يتميز بوجود تهديد مادي ومباشر (البندقية)، وهو أقل شيوعاً في سيرة “الأيام” التي تركز أكثر على الحرمان المعنوي.
خاتمة
«هروب وعودة» ليس مجرد نص؛
إنه مرآةُ طفلٍ يركض في الجبل، وفي قلبه وطن صغير يبحث عن وطن أكبر.
إنها سيرة خوف تحولت إلى حكمة، وسيرة جرح صار وعياً، وسيرة هروب عاد ليُؤسّس حضوراً لا يهرب من مواجهة الحقيقة.
هذا النص – بما فيه من وجع وشفافية وشجاعة – يثبت مرة أخرى أن الكتابة ليست ترفاً، بل هي العودة الأكثر أماناً من كل هروب.
إن قصة “هروب وعودة” ليست مجرد ذكرى عابرة، بل هي نتوء صخري في ذاكرة أحمد سيف حاشد، يستند إليه اليوم ليرى بوضوح كيف أن “الأمس” القاسي في ظل أب شديد، قد تمدد ليصبح “يوماً” بلا دستور ولا أمان في ظل وطن مفقود. وتبقى العودة الأخيرة، وإن كانت على مضض، هي العهد الأبدي للحياة: أننا نعود دائماً إلى حيث يكمن الأمل والوجع معاً، حاملين معنا قصصنا التي هي نسيج وجودنا.
نص “هروب وعودة!”
أحمد سيف حاشد
هربتُ إلى دار “الشناغب” دار جدي ـ والد أمي ـ وأظن أن “الشناغب” هنا جمع “شنغاب” ويعني النتوء، وربما “الشناغب” تعني قمم الجبال الموجودة ظهر ذلك الجبل الذي يعترش قمته دار جدي. لا أستطيع الجزم، ولكن هي محاولة لمعرفة العلاقة إن وجدت بين تلك التسمية والجبال الناتئة خلفه، أو العلاقة بين الدار ذاته والذي يبدو ناتئا في قمته، والجبال المتساندة خلفه متدرجة الارتفاع، والقمم كبيرها يسند الأصغر منها لتبدو رأس القمم نتوءات أو هامات متوالية، وفي هذا المقام يقول عبد الحافظ عبدالله القباطي شعراً:
الشمس تتخاوص قفا الشناغب
والسِّحر يسكب للقلوب مطايب
يبعدُ دار جدّي هذا عن منزل أبي بحدود خمسة كيلو مترات، ويقع في منطقة قريبة من حدود دولة الجنوب، التي كانت تعرف باسم “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”. يبدو هذا الدار من بعض تفاصيله أنه كان داراً حربياً، في رأس أحد الجبال، تسنده جبال أكبر وأعلى، وينفرد بوحدته فيها، وتوجد منازل عديدة في بعض الجهات المقابلة له شمالاً وجنوبا، وأسفل الجبل يوجد وادي يُسمّى وادي “الصِدر”.
وفي الجوار الملاصق للمنزل خزان ماء أرضي، وفي الدار كُوَّاتٌ، وشقوق طولية ضيقة، يمكن استخدامها في المراقبة، وإطلاق النار من البندقية إلى الخارج، حيث تسمح بمرور ماسورة البندقية إلى الخارج بقطاع وزاوية معيّنة، ويبدو أن هذا الدار قد شهد شيئاً مما خصص له في زمن مضى وانقضى.
أمّي سكنت هذا الدار قليلاً من الوقت قبل مجيئي، وقطنته أنا فترات قصيرة بصحبة أمّي في عهد طفولتي، حالما كانت أمي تحنق إليه من أبي. كنتُ أستأنس هذا الدار وأهله في طفولتي، وفي نفس الدار ولد أخي الأصغر عبدالكريم، الذي فرحتُ به كثيراً يوم مولده، بعد انتظار طال لأخ سيأتي بعد خيبات متكررة. كان جدّي سالم مانع – أبا أمي – يملك أيضاً داراً آخر اسمه “دار موجر”، وتفصله مسافة قريبة من “جن الداجنة”، ويبعد حوالي اثنين كيلو متر من منزل أبي.
جدّي هذا كان رجلاً فاضلاً ومسالماً وعرفته زاهداً.. طيب القلب، ونقي السريرة، يقضي كثيراً من وقته اليومي في قراءة القرآن والتحدث في تفاسيره وقصصه وأخباره.. كان تقياً، ورعاً، محباً، لا يحمل ضغينة، ولا يضمر شراً، ولم يعر بالاً أو اكتراثاً للسياسة، ومع ذلك دفع حياته لاحقاً ثمناً لأفعال الساسة، “قومية” و “تحرير” .. مشايخ “عليان” و “سفلان”.
* * *
أقبل أبي غضوباً وثائراً بعد ساعة أو سويعات قليلة من هروبي، رأيته من دار “الشناغب” دون أن يراني.. كنتُ مترقباً مجيئه، وكان حدسي في محله.. رأيته ممتطٍ حمارَهُ الأبيض الذي يشبه الحصان.. كان يعتني به ويهتم به كثيراً، وفيما أنا أرقبه وهو ممتطى حماره في الوادي، رأيت بندقيته مسطوحةً أمامه، مستعداً لاستخدامها في أول وهلة يراني فيها، أو هذا ما دار في خلدي لحظة مشاهدتي لبندقيته.. شعرتُ في مَقدمِه شراً وناراً تستطير.. أنخلع قلب أمّي الهاربة في بيت جدّي على ابنها الذي قد يطاله شر أبيه.
لحظتها أخذتُ قراري بمفردي.. لم أشرك أحداً فيه، وكان اتخاذ هذا القرار في لحظة ضيق وجزع.. كان اتخاذه تحت وطأة شعوري أن حياتي مهددة بالرصاص، أو مجهول مفزع سيأتي.. كان دافعي الأول هو النجاة مما سينالني منه، والبقية تفاصيل.
خرجتُ مذعوراً من الدار إلى الجبل.. اتجاهي كان نحو حدود دولة الجنوب.. كان أمامي مسلكاً وعراً، وجبالاً متراكمة لا أعرف لها طريق، ولكن الخوف الذي داهمني كان أكبر وأعظم منها.. ربما دار جدي لن ينقذني مما أنا فيه.. لعل هروبي نحو الجنوب أجد دولة تنقذني من جور أبي.. ربما أجد هناك نظاماً يتولَّى حمايتي، ولجم حماقة أبي.. شيء من هذا حدّثتُ به نفسي يومها.
واليوم يتبادر إلى ذهني وجه السؤال: هل يشبه اليوم الأمس؟! فأجيب: جنوب اليوم لم يعد كما كان.. لم يعد لنا بقايا وطن.. لا مقام هنا ولا رفعه هناك.. لا مجير هنا ولا مجير هناك.. بتنا هنا وهناك بلا دستور ولا قانون ولا دولة ولا نظام ولا أمن ولا أمان، ولا لقمة عيش كريمة.. كل الأمكنة بيّتوها جحيماً في جحيم أوّلها هنا وليس آخرها هناك.
* * *
وفيما أنا أهم بالتوجه إلى الحدود عبر مسلك وعر لم يسبق لي أن سلكته من قبل، أو حتّى تخيلته.. خالتي مريم ـ أخت أمي ـ أبلغت والدي أنني تركتُ الدار، وهربتُ إلى الجبل. كانت خالتي قوية الشخصية.. صارمة وحازمة.. تجيدُ الاستبسال والمواجهة، والتحريض أيضاً، وقراءة كتاب “الرمل” وفك طلاسمه، والتعاطي معه بما ترجوه.
أدرك أبي وجهتي، واستطاع الإسراع بحماره إلى الجانب الجنوبي الغربي من الوادي، ليقطع وجهتي في الجبل، ويحول دون وصولي إلى تجاوز الجبل الأول في اتجاه الحدود.. رأيته يشهر بندقيته، ويوجهها نحو الجبل الذي أنا فيه؛ فاختبأت خلف نتوء صخري في كنف الجبل حالما شاهدته يحاول قطع اتجاهي وطريقي.
وبعد طول تفاوض مع خالتي مريم، ورجال خيِّرين من عابري السبيل، التزم أبي أن لا يؤذيني، مقابل أن أعود إلى منزله.
ربما شعوري المبالغ فيه جعلني أفكر أن أبي بات يستقصد حياتي.. طفل يبحث عن فرصة نجاة من أبيه.. نادتني خالتي بأن أعود، ولن يلحقني شر أو ضرر منه، وبعد توجس طمأنني الجميع أن الأحوال ستكون لطيفة، إن لم تكن على خير ما يرام، ولن يحدث لي أي مكروه؛ وكان أبي بعد أن أدرك وجهتي، قد وعد أمام مشهد من الناس ألا يلحق بي ضرراً أو انتقاماً.. شرطه فقط أن أعود إلى منزله.. ربما بدا لي الأمر أشبه بصفقة ممكنة.
نزلتُ من الجبل بعد ما يشبه عملية تفاوض قادته خالتي من جهتي، فيما عاد أبي وهو يبلع غيظه، مستشعراً بعدم الرضا؛ لأنه لم يشبع انفعاله، ولم يشفِ غليله الفوار.
عدتُ بموكبٍ يحيط بي.. كانت بعض النسوة وأختي من أمي “هناء” إلى جواري يرافقن عودتي, وحوالي خمسمائة متر تفصلنا عن مسير أبي وحماره.. كان أبي ينتظرنا في كل منعطف حتى نقترب منه.
بدأتَ المسافة مع السير تضيق وتضيق أكثر.. وعندما بلغنا منطقة تسمى بـ: “سوق الخميس”، أغلب الظن أن أبي لم يحتمل أن يراني أسجل عليه ما بدا له انتصاراً مستفزاً. استفزه منظري الذي بدوت فيه المنتصر، وساورته الريبة بأنني أُشمت به، وأنال من سلطته وسلطانه.. ربما هذا ما فكر به، حالما كُنّا نتبعه في الطريق، وهو بين حين وآخر يرمقني بنظرات فارغة من التطبيع واللطف.
لم يحتمل أبي ما جاش في صدره الذي ظل يغلي، فثار غضبه فجأة.. تمتم بالسباب المنفعل، وصوّب بندقيته بانفعال نحوي.. حمتني النسوة بأجسادهن؛ وتعالى الصراخ والذعر في المكان. تدخل المارة، وكل من كان على مقربة منّا؛ وانتهت الجلبة حينما قطع أبي على مضض عهداً آخر للناس بألاّ يُلحق بي سوءاً أو ضرراً، وبر هذه المرة بوعده، ولكن على كره ومضض.
ربما لم يطق ابي أن يشاهد ما تصوره انتصاري المستمر عليه، وحتى لا ينكث عهداً قطعه مرتين أمام مشهد من الناس؛ أعادني إلى منزلنا القديم الذي كان يسكنه أخي علي، وليس إلى منزلنا الجديد الذي يقيم هو فيه.
عاد أبي بعد أيام ليتصالح مع أمي وأهلها، ثم عدتُ إلى بيت أبي من جديد في حضرة أمي التي ندمت أشـد الندم على ما حدث، وعلى تركها لي أياماً كنتُ خلالها أحوج ما أكون إليها بجانبي.
مر العيد بخسارة أقل.. مر بسلام صعب بعد أن كنتُ أتخيل أنه سيتحول إلى ميتم، أو مجهول لا أعرفه!! كنتُ أنا السبب الأهم في استمرار زواج أبي وأمي، رغم المشكلات والخطوب المتعددة التي مرّ فيها هذا الزواج الصعب، وأفلت منها بأعجوبة ربما تشبه المعجزة.