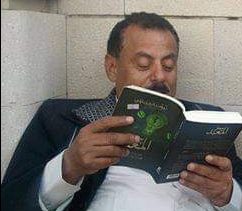مذكرات
(6) احتجاج وأسئلة تتناسل كالضوء.. أحمد سيف حاشد
مذكراتي.. من تفاصيل حياتي قسوة.. طفولة بطعم التمرد..

(6)
احتجاج وأسئلة تتناسل كالضوء
أحمد سيف حاشد
وأنا طفل كنت أتخيل الله بحسب الحال الذي هو فيه من غضب وفرح واستراحة ومسرّة.. وهو يراني في كل حال.. وأتخيل الملكان يرافقانني في كل الأوقات، ولا يتركاني حتى عند الذهاب لقضاء الحاجة..
كنت أسأل عن الله، وأتخيله في معظم الأحيان رجل ضخم بطول السماء مستريح على أريكه ضخمة، أو سماء ملساء اشبه بمرآة عريضة عرض السماء، وهو مستريح عليها ينظر إلينا ويتابع أفعالنا من مكانه، وأحيانا أتخيله مستريح على سرير عظيم، أو جالس على محفة عظيمة وثمانية من الملائكة العظام يحملونه، أو هكذا قيل لي.. ثم تتغير هذه الصورة في مخيلتي وأنا أتخيل الله يغضب من أسئلتي ويتوعدني بالعقاب والنار.
كنت أسأل أمي وأسأل الله أسئلة أشعر أنها تغضبه.. أتساءل بتلقائية أو بفضول معرفي، وأحتار مع كل سؤال يتفجر داخلي، ولا يجد له جوابا، أو أجد له جوابا، ولكنني أتشكك بصحته، ويميل ظني إلى أنه جوابا مغلوطا أو عاريا من الصحة..
لأول وهلة تبدو بعض الأسئلة بسيطة، ولكنها تشبه السهل الممتنع.. كانت أمي تارة تتجاهل سؤالي، وأحيانا تجيب على نحو لا أتصوره، وفي بعض الأسئلة الصادمة، كنت أرى وجه أمي مصعوقا بالخوف والهلع.
كانت بعض الأسئلة كبيرة، وربما صغيرة، ولكنها كانت تدق أبوابا كبيرة، وإن غرق بعضها ببعض التفاصيل التي لا تأتي على بال الكبار.. بعض الأسئلة كانت تلقم فاه أمي عجزا بحجم جبل، فيلبسها الخوف والهلع، وتسارع بتحذيري الشديد، وبما هو مرعب ومهول، وتقمع سؤالي بشدة وصرامة..
طبعا تلك الأسئلة وما قبلها لم تكن بهذه الصيغ التي أكتبها الآن، بل كانت بصيغة أخرى، أو مقاربة أو مؤدية لمعناها الذي أستحضره هنا وأكتبه.
أسئلة لا تنتهي، بل تتناسل وتتكاثر، تواجه بقمع وتعنيف وغياب جواب، أو جواب خطاء أو مغلوط أو كاذب لا استسيغ بلعه، أو أبلعه بصعوبة على غير اقتناع إلى حين.
***
لم يكن قمع الاسئلة منحصرا على البيت، بل كنت أجد مثله حتى في المدرسة..
كان مدرس العلوم منهمك في شرح الدرس.. وكنت أستمع إلى شرحه، وتتكرر كلمة “البراز” في الشرح دون أن أعرف ما هو هذا “البراز”!! أول مرة أسمع بهذه الكلمة ولا أعرف ماذا تعني!! بالتأكيد زملائي مثلي، ولكنهم ربما لم يتجرؤون على السؤال.. سألت الأستاذ: أيش هو هذا “البراز”؟!
فأجاب بضيق، وبحركة عصبية من يده وقدمه محاولا أن يشعرني بغبائي وإحراجه من الجواب بقوله: “الخر”.. فضحك من في الفصل.. وهو ما جعلني أصاب بإحراج شديد.. ولو كان سأل به الاستاذ كل زملائي في الصف لعجزوا عن جوابه.. أغرقني الخجل في الصف، وتحملت النتيجة لوحدي وعلى مضض، فيما استفاد الجميع من الجواب، وكنت الشهيد.
***
كنت أسأل: لماذا ثابت صالح فقير؛ وهو طيب ومكافح ويكدح بأجر قليل؟! ولماذا “فلان” غني وهو ظالم ومحتال وشرير بحسب ما أخبرتني به أمي؟!
فتجيب أمي: هو الله؛ وفي الآخرة سيتم انصاف من تم ظلمه في حياة الدنيا..
أسأل: لماذا نذبح كبش “العيد” ونسفك دمه؟!
فتحكي لي أمي قصة اسماعيل ووالده إبراهيم عليه السلام..
أسأل: لماذا قطتنا المسكينة والأليفة تأكل صغارها، وما ذنب الصغار ليتم أكلهم؟! إنه فعل يترك لدي حزن وحسرة، وغصة كبيرة في الحلق..!!
فتجيب أمي: إنها حكمة الله في خلقه..
***
تسألت يوما: هل سيعاقب الله الثعلب الذي خطف ذات يوم دجاجتنا من قنّها جوار دارنا في لجة الليل البهيم.. كانت تصرخ وتستغيث بصوت مفجوع يفطر قلبي.. صوت لم أسمع مثله من قبل.. كان أوجع من الموت وأكبر من مكبر الصوت.. لا مغيث لها ولا مجير.. كان صوتها صارخا يشق الليل نصفين، وكأنها تطلب من الوجود أن يفعل شيئا من أجلها؟!
ضرب أبي رصاصة دهشا، لعل الثعلب يتركها فزعا من صوت الرصاصة الذي ربما يعادل صوت المستغيث، غير أن الثعلب لم يترك وليمته، وأخمد صوت دجاجتنا وأنفاسها إلى الأبد.. كدت يومها أن أحتج على الرب، وعلى هذه الحياة الكاسرة.. صوتها إلى اليوم أستطيع أتذكره بوضوح بعد أكثر من خمسين عام خلت.. لقد مزق صوتها سكون الليل، وقدح صوتها الصارخ بالشرر.. صوت لا أريد أن أتذكره؛ لأن استعادة صوتها في ذاكرتي يجلب لي كثير من الألم، ويذكرني بالاختلال المريع للعدالة، وكم هي هذه الحياة قاسية..!
***
في إحدى الأيام حدث زلزال بعيد أو هزة أرضية خفيفة أستمرت لثواني قليلة أخافتني بعد أن عرفت أنه كان من الممكن أن يقع دارنا على بعضه، ويسقط السقف على رؤوسنا.. كنت أسأل: لماذا الله يزلزل الأرض؟! فتجيب أمي إن الأرض على قرن ثور، فإن حرك الثور قرنة وقع الزلزال وحلّت الكارثة.. وحالما أسألها على ماذا يقف هذا الثور التي تقف الأرض على قرنه!! لا تجيب، وإن ألححت بالسؤال تجيب إنها لا تعلم ولا تدري.. فجوة في وعي طفل تظل تكبر وتتسع طالما لم يجد جوابا مقنعا أو مستساغا أو ما ينطلي عليه..
أسأل: لماذا الله يقتل الأطفال في الزلازل والسيول؟! ثم أتذكر ما قيل عن السيل الذي جرف حميد من رأس وادي “شرار”، وسمي ذلك السيل باسمه، وربّما البعض أرّخ لبعض الوقائع والأحداث من يوم سيل حميد، كأن يقول: فلان ولد قبل سيل حميد..
كنت أتخيل المشهد وأنا أذهب كل صباح لمدرسة “المعرفة” بـ “ثوجان” مشيا على الأقدام، وأمر كل يوم من نفس المكان أو قريبا منه، والذي قيل أن السيل جرف حميد منه.. كنت أتخيل المشهد وأتخيل معركة غير متكافئة بين الضحية حميد التي خارت قواه، ودفر السيل العنيف العرمرم..
اليوم بات الفساد والاستلاب أشد من طوفان نوح.. جارفا أكثر من “توسنامي”.. ترحم البعض على فساد زمان.. لازلنا نحاول النجاة بقارب أو سفينة لعل وعسى أن ننجو من كارثة نعيشها من سبع سنين.. لا شجرة ولا جبل يعصمنا مما نحن فيه.. نحاول النجاة بسفينة نوح وبوعي حكيم ألف الصبر وخبر الصمود.. نحن أمام طغيان يعتاش على الموت والدم.. يجرف من يجد في طريقة..
نصمد ونقاوم الكارثة.. ننتظر أن ينحسر هولها لنتمكن من النجاة والعبور ببقايا وطن إلى مأمن أو ملاذ.. هذه الحرب الكارثة تعتاش على القتل والفساد والدمار والخراب الكبير، ولا تريد أن تنتهي أو تشهد زوال غير زوالنا نحن، أو تلاشي وعينا..
***
أسأل أمي: لماذا الأمراض تفتك بالصغار؟!
لماذا الحصبة التي هددت يوما حياتي، تفتك بالأطفال أمثالي، ومن هم أصغر مني.. أطفال لا يقوون على مقاومة المرض، ويرغمون بالموت على فراق من يحبون؟!
فتجيب أمي: إن الأطفال الموتى يقيمون في الجنة.. والجنة فيها كل ما يطيب ويتمناه الإنسان، وإن أختي نور وسامية مع بنات الحور في الجنة، وإنهن سيشفعان لنا يوم القيامة، وندخل الجنة بهما، أو سوف تستقبلاننا على بابها..
كانت أمي تخبرني أن الموت يأتي في صورة رجل أعور فيقبض روح الإنسان.. وكنت أسأل لماذا الموت أعور؟!
فتجيب أمي: لأن نبي الله موسى فقع أحدى عيناه قبل أن يقبض روحه.. لطالما تمنيت أن يكون موسى قد قتله وأراحنا من حزن فراق من نحب.
***
وتخبرني أمي أيضا أن “الحلابين” عمياء، فأسأل أمي لماذا هي عمياء؟!
فتجيبني: أن الثعبان زاد على “الحلبان” ومكر به؛ فأخذ “الحلبان” أرجل الثعبان في صفقة تبادل ماكره، وأخذ الثعبان عيني “الحلبان” وسرعته..
أحسست بالحسرة أن تكون “الحلابين” عمياء لا ترى، وفوق هذا صارت مُعاقة الحركة بالأرجل الكثيرة، فيما الثعابين أخذت من الحلابين نظرها وسرعة حركتها.. إنه المكر الذي أنتصر وأستمر وسوف يستمر إلى آخر الزمان..
بدت لي الصفقة مجحفة بحق “الحلبان” المسكين والطيب، وقد خسر الصفقة على نحو فادح، وبات معاق النظر والسير، في صفقة لم تكن عادلة..
ولهذا كنت وأنا أرعي الأغنام في الجبل أتعاطف مع “الحلابين” عندما أجدها بعد المطر تسير ببطيء ومشقة، فأنقلها من مكان إلى مكان آخر أفضل، وأختصر لها الطريق بحملها إلى ذلك المكان الذي خمنته إنه الأفضل، وما كانت لتهتدي إليه دوني. ثم أجد بعض غنمي قد شردت بعيدا عنّي حالما كنت منهمكا في نقل “الحلابين”.
***
كانت أمي أحيانا تحاول الإجابة، فتعجز وتقمعني وتمنعني من هذه الأسئلة التي تقود إلى الكفر وعذاب النار، أما أبي فلا أتجاسر على سؤاله لهيبته وخشيتي من عقابه.. كانت أمي أقرب إلى وجداني من أبي.
كنت بأحد المعاني أثور بالأسئلة، ولم أجد لها جوابا كاف وشاف.. كنت أسخط على من يستسهل الموت، ويهدر الحياة، وينتج العنف والقسوة، ويسوّغ الظلم ويبرره.
أسأل نفسي وأسأل أمي بما معناه: لماذا لا يساعدني الله على حفظ سورة الفاتحة كما يجب؟! لماذا لا يخلق الله لنا من أجل قرآنه عقل يحفظه، أو ذاكره تجعل من السهل علينا قراءته وحفظة طالما هو كتابه وكلامه؟!
ثم تتناسل الأسئلة لتنتهي بالسؤال عن الله: كيف هو؟! وكيف أوجد نفسه؟! وكيف كان الحال قبله؟! فلا ألاقي جوبا، بل أجد صدّا وغضبا يشتد، وزجر يمنعني من السؤال ثانية.. ولكن تظل الاسئلة تجوس داخلي لا تهدأ ولا تتعب ولم ينجح القمع في القضاء عليها..
***
قبل أن أعرف معنى الزواج، كنت أعرب عن رغبتي في الزواج من جارتنا التي تكبرني بأربعة أضعاف عمري؟! وفي إحدى الأيام حاولت أن أتشبث بها وأمنعها من الرواح إلى بيتها من دارنا، لأنني أريد أن أتزوجها، دون أن أعلم شيئا عن حقيقة الزواج وماهيته، أكثر من مكوثها معنا في دارنا..
وعندما كبرتُ بدأت أعرف شيئا عن الزواج، وكنت أشاهد وجهي في المرآة وأرى قبحي في جحوظ عيناي، وأكثر منه كنت أجد بعض من هم في عمري يلفت أنظارهم جحوظ عيني.. وأحيانا أجدهم يعايروني بها، فتترك في أعماقي ندوب ربما تدوم سنين..
يوما سألت أمي بصيغة مؤداها: لماذا الله أقبحني بعينين جاحظتين ولم يساويني بأقراني؟! فأجابت أنها سمعت من أبي “انني أشبه جدي هاشم في عيونه”.. إنها جينات توارثت وتعدت أبي لأكون ورثيا لما لا أريد.. ومرة قالت لي إنها توحمت على طفل كان جميلا، وعيناه الواسعتين كانت أكثر جمالا..
هكذا ربما فكرت يوما.. لم يكن لي خيار حتى في أن أختار عيوني أو وجهي أو شيئا مما يخصني في بدني.. أبسط الأشياء الخاصة بي لم تكن طوع يداي.. ولم يكن لي فيها مدخلا أو خيارا.. لم أقررها ولم يتشاور من خلقني كيف يمكن أن تكون.. إنها أمر كان بكامله خارج رغبتي وإرادتي..
وعندما كبرت قليلا كنت أسأل نفسي: هل سترضى بي من أحبها أن تتزوجني، رغم تلك البشاعة التي خلقها الله في عيوني، وحرمني من وسامة ما كان ينبغي أن يحرمني الله منها؟!
وفي مرحلة لاحقة ربما بديت في مخيالي أمام نفسي أشبه بالجاحظ في جحوظ عينيه.. الجحوظ الذي غلب على اسم صاحبه.. عرفه الناس باسم الجاحظ أكثر من عمرو بن بحر.. قيل أن لقب الجاحظ كان غير مرغوب لديه، بل ويكرهه إلا أنه في سنّ شيخوخته أعتاده وأُشتهر به..
يبد أن هذا الجحوظ هو الذي جعل صاحبه يبدو دميم الوجه، حتى روى إن إمرة طلبت منه أن يرافقها إلى الصائغ لينقش لها صورة شيطان على الخاتم يشبهه، لظنها إنه يشبه الشيطان.
وجدتُ نفسي لست وحدي من ناله القبح واحتج عليه، بل أن الشاعر الحطيئة هجاء وجهه بقوله:
“أَرَى لِي وَجْهًا قَبَّحَ اللَّهُ خَلْقَهُ * * * فَقُبِّحَ مِنْ وَجْهٍ وَقُبِّحَ حَامِلُهُ”
عندما ترشحت لعضوية مجلس النواب ألصق فريق حملتي الانتخابية صور في إحدى مناطق دائرتي الانتخابية، وعند مروري فيها، لاحظت بعض الصور قد تم تشويهها بخرف عيونها، وترك باقيها كما هو من دون عيون.. فاستيقظ احتجاجي، ودفعني هذا إلى بذل نشاط مضاعف، وإصرار عنيد على انتزاع النجاح، ردا على ممارسة القبح الذي وجدته يُصبَ على عيوني المتعبة والمعذّبة..
أما اليوم وبسبب حساسية في عيوني باتت مزمنة، مضافا إليها كثرة السهر وقلة النوم، بات الاحمرار شديدا وملازما لها، ولكن من يحملون القبح في عيونهم وعقولهم ، ينسبون لي تهمة “اللبقة”، وقصدهم أنني سكرانا طوال الليل والنهار، وهو جزء من الكيد السياسي الذي يستخدمه هنا بعض الخصوم السياسيين في الجماعات الدينية للنيل والتشويه من صاحبه أمام العامة الذين يشنّعون على شارب الخمر أكثر من تشنيعهم على القتلة والنهابة والفاسدين والمحتالين..
تذكرتُ هنا ما قرأته من طرائف الجاحظ؛ حيث يُحكى عنه أنه توجه إلى اليمن، ودخل أسواقها وتجول في كثير من أحيائها، ولكنه وجد الناس ينفرون منه لبشاعة شكله، ولم يستضيفه أحد، وفي طريق عودته إلى البصرة، قابل أحد رفاقه، فسأله: كيف حال اليمن وأهلها؟
فأجاب:
منذ أن أتيت اليمنا لم أر وجها حسنا
قبــــح الله بــــلـدة أجمل من فيها أنا
***
يتبع..