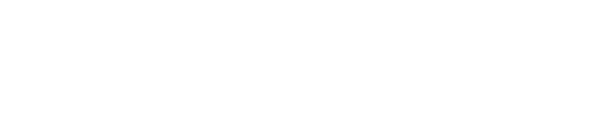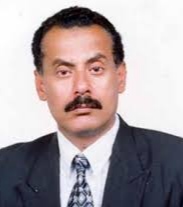قراءة تحليلية لنص “فضاءٌ ضاق بطائر” لـ”أحمد سيف حاشد”
نموذج مقاومة وجودية ضد الإذلال الطبقي والفرعنة الاجتماعية

برلماني يمني
المواطنة لا تُبنى على الأصل أو القبيلة، بل على ممارسة العمل والالتزام الأخلاقي
معركة الأب ضد الفقر والمرض، ومعركة الابن ضد التخلّف الاجتماعي والاستبداد السياسي
نقد لاذع لجذور العلل في المجتمع اليمني
فضاءٌ ضاق بطائر
أحمد سيف حاشد
كان أبي عاملاً.. مُفنِّداً للجلود في سنين من حياته.. هي مهنةٌ مُحتقرَة عند البعضِ باعتبارها امتداداً لدِباغة الجلود.. مهنة مُحتقَرة عند من يتملَّكهم الخَوَاءُ و”العنطزة”، والّذين يعيشون على السّلبِ والنهب، والفساد في الأرض، وغير القادرين على فهمِ أنّ العملَ طالما كان مشروعاً، هو قيمة اجتماعية وشرفٌ كبير؛ لأنّ صاحبه يأكلُ من كدِّه ومن عرق جبينه.
كان أبي يعمل في شركة (البِسْ) بعدن، يفنِّد الجلود، وهي الحرفةُ الّتي أعطاها الجزء الأهم من زهرة عُمره وريعان شبابه.. العمل بتفنيدِ الجلود له أضرارٌ صحية، ولكنْ يبدو أنّ أبي وهو يلتحق بالعمل في هذه الشركة قد آثر فرصة العمل على البِطالة، وأنفد المثل القائل “غُبارُ العمل ولا زَعفران البِطالة”.
بسبب الملح والجلود، والمواد الكيمائية المستخدمة أُصِيبَ أبي بضيق النّفَس، وسُعالٍ ليلي، رافقه حتى آخر أيام حياته.
خِلالَ أكثرِ من خمسين عاماً من عمري، لم أكن أعرفُ أنّ هناك فئاتٍ سكانيةً، أو مجتمعيةً في اليمن تحتقرُ مِهنةَ دباغةِ الجُلود، والعاملين فيها، وتنظر إليهم نظرة دونية!.. كانت الفكرةُ الراسخةُ في ذهني أنّنا ننتمي إلى طبقة الفقراء فحسب، ولم أعلمْ أنّ هناك فئاتٍ سكانيةً، وبيئاتٍ قبليةً، وبدويةً، ترانا دونها إلّا في فترةٍ ربما متأخرةٍ من حياتي.
أبي بدأ حياته المهنيةَ عاملاً في “تفنيد الجلود”، وينتمي إلى الطبقة العاملة، أو قُلْ إنْ شِئتَ إلى أُسر ذوي الدّخلِ المحدود، وتُعتَبر هذه المهنةُ بوجهٍ ما ذاتَ صلةٍ وامتدادٍ لمهنة الدِّباغة.
في العهد الاشتراكي بجنوب اليمن، وجدت حمايةً قانونيةً، ونصوصاً عقابيةً لمن يُعيِّرُ أو يحتقرُ، أو يسيءُ إلى مواطنٍ بسبب انتمائه المهني، أو حتى الطبقي المتدنّي بقصد الاحتقار والإساءة، بلْ أذكرُ أنّ قانونَ العقوباتِ النافذَ وشروحاته، تقرِّرُ أنّه إذا وجَّه أحدٌ إساءةً بالغةً، أو استفزازاً وتحقيراً شديداً إلى شخص، من شأنها أن تحدث لديه هياجاً نفسياً شديداً ومباشراً، وارتكب من وُجِّهت إليه هذه الإساءةُ جريمةَ قتل، فلا يقاد القاتل به.
بهذا الصدد شروحاتُ قانونِ العقوباتِ الصادرِ عام 1976 تُعيد السببَ إلى أنّ فِعلَ القتلِ ارتُكِبَ من قبلِ الجاني في لحظةِ الهياج النفسي الشديد جرّاء الإساءة البالغة، وعلى نحوٍ أخرجتْ مُرتكبَ الفعلِ عن حالته الطبيعيةِ، ومن وعيه بتقدير أفعاله، تحت تأثير ذلك الهياج الذي تسبّب فيه المجني عليه، وقد قيّد القانونُ القاضي بالحدِّ الأقصى لعقوبةِ الحبس بما لا يزيد عن خمس سنوات.
كما أنّ الثقافةَ والوعيَ السائدَ في الجنوبِ آنذاك، كان منحازاً أيديولوجيّاً لصالح طبقات الفقراء، أو ما كان يسميهم طبقات العمال والفلاحين، وفئات الحرفيين والصيادين وغيرهم، أو من كان يعتبرهم إجمالاً بـ “أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة”، بل وصل الأمر بهذا الوعي إلى الحدِّ الّذي جَعَلَنا نعتزُّ بهذا الانتماء، ونجلُّ فقرنا باعتزاز، ولم نشعرْ بأيّ انتقاصٍ يوماً بسبب المهنة، أو تدنّي المستوى الاجتماعي لنا.
وأكثرُ من هذا، كانت توجدُ إجراءاتٌ اقتصادية، واهتمامٌ لافتٌ وبحماس فياض، يتم بذله من قبل السلطات نحو شريحة المهمشين، والعمل على رفع مستواهم الاقتصادي والتعليمي، والاجتماعي، وتم بذلُ محاولاتٍ كثيرةٍ ومتتابعةٍ لإعادة دمجهم في المجتمع، ولاسيّما في عهدِ الرئيسِ سالم ربيع علي المشهور بـ “سالمين”.
وكانت من الهُتافات الأخَّاذةِ والآسرةِ في ذلك الحين، التي سمعتها من قِبَلِ المهمّشين في أثناء دراستي الإعدادية في طور الباحة بسبعينيات القرن المنصرم هتافٌ:
“سالمين قدام قدام ** سالمين ماحناش اخدام
سالمين عُمّال بلدية ** سالمين منشاش أذية ”
وتمّ منعُ وصفِ أيِّ عامل بلدية بالخادم كما كان سائداً من قبل.
* * *
بعد انقطاعٍ طال بين أبي ومهنته السابقة، عاد إليها مرة أخرى مضطراً، بعد أن ألجأته إليها مسيس الحاجة والعوَز، وبعد أن نفد ما يملك ويدّخر من مال، وتشرُّدٍ طال لسنوات، على إثر استشهاد أو مقتل أخي علي سيف حاشد في القرية، ومُلاحقة والدي من قِبَلِ سلطة صنعاء في ذلك الحين، والّتي كانت تسعى لاعتقاله دون أن يقترف أيّ جريمة، وأكثر من هذا أنّه لم يمارس السياسة بأيِّ وجه، ولا يوجد لديه أيُّ انتماءٍ سياسي، غير أنّه أب لأخي علي، وحمله لحزن ثقيل أناخ كاهله إثر مقتله.
استمرّ أبي بهذا العملِ للمرّة الثانيةِ “تفنيد الجلود” قُرابةَ السنتين أو أكثر، في بخَّارٍ كائنٍ في حيّ “الخساف” بـ”كريتر” وذلك في ثمانينيات القرن المنصرم، لدى صديقه الودود عبد الحميد، رغم استمرار معاناة والدي من نوبات السُّعال الليلي، الناتجةِ عن عمله السابقِ بنفس المهنةِ في شركة “البس”.
وعن مهنة والدي الّذي عاد إليها مرةً أخرى، يقولُ “عامر علي سلام فوز” الذي زامن والدي لفترة في العمل: ((كان سيف حاشد رجلاً عصامياً، ولي الشرف في العملِ معه، في بخّار عبد الحميد في “الخساف”.. حيث كان والدي “علي سلام “يعمل سائقاً عند عبد الحميد، فيما كنت أنا وأخي في إجازة الصيف المدرسية نعمل أيضاً في تفنيد الجلود.. كان يتمُّ جلبُ كلّ أنواع الجلود المملحة والجافة من الشيخ عثمان، والشيخ الدويل إلى البخّار، ونحن نستلمها في المستودع، حيث يقوم عمي سيف بتفنيدها (وهي عملية فرز مهمة جداً، وتحتاج لدراية وحنكة في تصنيف الجلود، وليس أيُّ كائن يستطيع أن يتعلمها، حيث تُقسّم الجلود إلى نوعين، جلود الماعز (التِّيُوس)، وجلود الخرفان.. وبالتالي يعتمد المُفنِّد على فحصه لكل جلد إن كان درجة أولى أو ثانية، أو ثالثة، أو رابعة.. ولكلّ درجةٍ لها تسميتُها.. صافي درجة أولى.. كشر درجة ثانية.. وأقلُّ من ذلك ثالثة ورابعة.. وبعد الفرز والعدِّ أيضاً نقوم بإضافة السم مع المِلح المخلوط إلى كل جلد، وعمل رصَّات خاصة لكل نوع في البخَّار الّذي كان يتسع لكميات كبيرة من الجلود.. وفي أثناء الطلب الخارجي نقوم بوزن الجلود على شكل بُنَدٍ كبيرةٍ، ندخلها في مكينة ضغط خاصّة برُزمِ الجلود، وربطها بإحكام، ونأتي بالجواني (تغليف كلّ بُندةٍ على حده) ووزنها ثانية للاطمئنان، ونكتب عليها بفرمات محددة اسم الدولة الّتي نصدّر الجلود إليها، أو اسم الميناء..!! ومن ثَمّ تُحملُ إلى الميناء، وتُشحن في السُّفن إلى أوروبا (إيطاليا/ فرنسا/ وغيرها) ويتم مراسلة الشركات عبر مكتبٍ خاص، وكان التاجر عبد الحميد يتعامل معه)).
كان عملُ أبي في تفنيد الجلود هذه المرة مضطراً أكثر من المرة السابقة، وآثر والدي العمل في هذه المهنة التي يجيدها، أو كانت متأتية للعمل فيها، رغم تأثيرِها على مستوى صحته، أو بالأحرى على ما بقي لديه من صحة.. وبين العمل في بداية العمر وغاربه، عمر مديد وعمل كديد، وصحة تذوي، ولكنها تقاوم بعناد وصبر لا ينفد.
هكذا هم الفقراء يؤثرون العمل على الصحة، مهما كان الخطر عليها أو مهددا لها.. إنَّهم يؤثرون العمل على ما عداه، وإن كان فيه تراجعٌ أو تلاشٍ أكبر أو محتمل للصحة..
يموتون وهم يعملون بمثابرة من أجل أن يُعيلوا أسرهم بالرِّزق الحلال المندّى بعرق الجبين، ولو بما يفي بالحدِّ الأدنى من كرامتهم، وكرامة أسرهم المحرومة من الكثير، ودون أن يخطُر لهم بال، أو هاجس شيطان عابر، أو شيطان يجوس في الحِمى، ليمارس النَّهبَ أو القتل، أو حصد الغنيمة من تحت ظلال السيوف، أو يجني المال الوفير من مصدر مشبوه، أو عمل غير مشروع.. إنني أعترف لآبائنا.. لقد كان آباؤنا كباراً بحقّ وجدارة.
عرفتُ أبي خلالَ مسيرةٍ حياته أنّه يقدِّس العمل، ويقدِّس مواعيده بدقَّةٍ حدَّ القلق، ويعمل بمثابرةٍ دون توانٍ أو كسل، ويبذل جُلَّ اهتمامه وعنايته في العمل، ويسعى بمثابرةٍ لتحقيقِ أكبر قدرٍ مُمكنٍ من الإنجاز.. وينام مُرهقا ولكنّه مستريح الضمير، ويقوم باكراً من فراشه، وبنشاط متجدِّد، ويقظةٍ وجذوة، تستمر معه طوال ساعات العمل.
* * *
في صنعاء خلال سنوات الحرب كتبت عن أبي الدبّاغ منشوراً على صفحتي في “الفيسبوك” معتزاً بمهنته، ولأول مرة عرفت من صديقي ورفيقي القاضي عبدالوهاب قطران أنّ مهنة دباغة الجلود لدى بعص مناطق وقبائل الشمال مهنة محتقرة، ويعتبرون أصحابها ناقصي أصل، مثلهم مثل المزاينة والحلاقين والجزارين، ومن في مستواهم، أو دونهم.. وزاد من الشعر بيتاً كان منتشراً بين القبائل:
“تجنَّبْ صُحبةَ الأنذالِ تسلمْ
مُزيِّن ثُمَّ حجَّام وجزَّار
وقشّامٌ ودوشانٌ ودبَّاغٌ وحائكْ”
ومهنة “تفنيد الجلود”، هي امتدادٌ لمهنة الدِّباغة، أو ذات صلة بها، كما تمّ إلحاق فئة الدبّاغين بفئة الجزارين استنادً إلى الصلة في المهنة، في إطار نظرة تراتبية اجتماعية تنضح بالعنصرية الفجة وعياً وممارسة.
عرفتُ شيئاً آخر في أثناء حديثي مع زميلي ورفيقي في الكلية العسكرية “حسين” من الجوف، الَّذي ألتقيت به خلال فترة الحرب.. عرفت منه أنَّ مهنة البيع والشِّراء إلى تاريخ غير بعيد، كانت لدى بعض قبائل الجوف معيبة على من يمتهنها، وأنها – من وجهة نظر هؤلاء- مهنة غير مرغوبة، وغير محترمة، ويلحق العيبُ بمن يمارسها، وقد عمل أبي أيضاً في هذه المهنة فترة طويلة.
هكذا يتم قلب المفاهيم والقيم رأساً على عقب، أو أنَّ منتجي تلك القِيم هم المقلوبون على رؤوسهم، وبالتالي ينتجون مفاهيم وقيماً خاطئة، وبعضها مقلوبة كوضعهم المقلوب، معتقدين سويِّتها واستقامتها، ليتحوَّل في نظرهم من يمارس العمل الشريف، ومن يأكل من عرق الجبين، مقذوفاً بالعيب، ولعنات تلاحقه كقدر لا مفرَّ منه، هو وبنيه ومن تناسل منهم.. تدركهم اللعنة لتدمغهم بالعيب والانتقاص والاحتقار والازدراء العنصري الناتج في حقيقته عن تشوّه أو خواء عميق في الوعي، ومنطق سطحي رجعي متخلّف.
ويظل اعتزازي الكبير بعمل والدي، وبكل المهن التي مارسها طيلة حياته، دون أن أنتقص يوماً من إنسانية أي فئة اجتماعية، بل أمقت التصنيف العنصري، وتراتبية الأصول التي تؤدي لحصر الأصول الناقصة واحتقارها، وأزدري الاصطفاء، وأرفض التفكير النمطي التقليدي القائم على تراتبية فيها احتقار الإنسان لأخيه الإنسان.
زدت اعتزازاً بمهن والدي، ونظرتُ إليها من بُعدٍ آخر غير البعد الذي ينظر إليها بعض من يعانون عُقد النقص، وخللاً في الدماغ، وتشوّهاً في التربية والتنشئة الخاطئة.. في واقعٍ كهذا، أميل إلى تقدير أكثر نحو من ينبت في الصخر كشجرة التين الشوكي، أو الصبّار أو شجرة السدر، وقد تحّدت كل الظروف الطاردة للحياة، وعاشت رغم قسوة الطبيعة، وشمخت متحديةً وباسقةٌ، بل وزادت تُزهرُ وتُثمر، في أعز الفصول ضيقاً، وكأنِّ وجودَها المعاند، فيه حكمةٌ ومقاومةٌ، وتحدٍّ لوجع الطبيعة، وتشمخُ برأسها علواً، وتزهر أطرافها بألوان زاهية، وتعطي النحل والناس رحيق العسل.
أعتز أنَّني ابن هذا الأب المكافح، الَّذي أنتمي إليه، وصار ولده نائباً للشعب، ويمثله بما يليق به، وقد حرِصتُ وأنا أختار أنْ أكون لا منتمياً، أو أكون نائباً برلمانياً مستقلاً بحق وحقيقة.. صاحب رأي وموقف حر ومستقل، وأن يكون “الشَّريم شعاري” وأن يتكثف إعلاني ووعدي الانتخابي بعبارة “انتخبوا من يمثلكم لا من يمثّل بكم”.
أغلبُ الظنِّ أو كما أتخيل نفسي أنني مازلت حريصاً ووفيَّاً لهذا الشعب المنكوب بمن قادوه وتسلطوا عليه من أعالي القوم وأشرافه.. مازلتُ وفياً للعهد والوعد الذي قطعته يوماً للوطن، وقد خان أسياد القوم شعبهم، وسقطت المنازل الرفيعة في القيعان السحيقة، وسيكنس التاريخ – يوماً – كثير من أصحاب المراتب العالية إلى مزابله المنتنة، وكلَّ من جلبوا لهذا الشعب الكوارث العظام، ومارسوا بحقه الخيانات الكبار بتمادٍ بالغ، ومجاهرةٍ فجَّة وصارخة، وأتوا بالعار الذي لا يُمحى ولا يزول إلى اليمن بطولها وعرضها!!.. ليس حديث الأنا ولكنْ، هو الاعتزاز، إنْ لم أعتز بهذا فما الذي بقي لأعتز به؟.
والخلاصةُ أنّني أمقتُ التّفكيرَ النّمطي، في التراتبيات الاجتماعية المتخلفة، أو القائمة على الأصل، أو الحسب والنسب، أو التفكير العنصري بكل مسمياته، وأرفض العصبيات المنتنة، وضخ الكراهية التي تستهدف الوطن في عُمقه ووحدته ومستقبله.. ولا بأسَ أنْ أقولَ هنا وفاءً لأبي: “كم أنت عظيم يا أبي!” .
* * *
بعد ما قاله لي صديقي حسين، وما كشفه لي رفيقي عبدالوهاب قطران عن معنى انتمائي وأمثالي في الثقافة والمخيال الشعبي، لدى بعض قبائل ومناطق اليمن، أو بعض المجتمعات المحلية فيها، وما يلحق صاحبها من الانتقاص والنظرة الدّونيّة، لم أخجلْ ولم أتخفّ ولم أحاول جبر ما بدا مكسوراً، أو ستر ما انكشف، بل على العكس، دافعت عمّا أعتقد باعتزاز يليق، ولم أخشَ من معايرة، ولم أتحرّجْ من عمل والدي، أو من المهن التي ارتادها خلال تاريخ حياته، بل اعتززت بنفسي كثيراً، وبأبي الذي حفر في الصخر من أجلنا لنعيش بكرامة، واعتززتُ بانتمائي الذي استطاع أن يحجز له مكاناً في الصخر الصّلد، وبتحدٍ مضاعف، ليكون وأكون كما يجب.
غيرَ أنَّ الأهم أنَّني لم أنجرْ إلى البحث عن عصبيةٍ صغيرةٍ مقابلة، تقتل أو تشوّه الإنسان الكبيرَ الَّذي أدّعي أنه يملؤني، ويسكن وعيي ووجداني، ويدأب إلى تحصيني من أي هشاشة تعتريني، ولم أتنازلْ عن الضابط الاخلاقي المنسجم مع هذا الإنسان الذي يسكنني، أو الإنسان الذي أبحث عنه خارج وجودي.
لا يعني هذا أنَّني لا أقاوم، ولا أهاجم الاستصغار الذي يحيط بي، أو يحاول أن ينال من شرائح وفئات مجتمعية من حقها أن تحظى بحقوقها كاملة، وأولها حق المواطنة.. لم أبحث – يوماً – عن انتماء آخر لا يليق بي كإنسان أولاً. ولكن أيضاً لزم أن نثور في وجه الفراغ والفرعنة.
* * *
أنا لا أفتري ولا أدّعي محض باطل.. لستُ المهدي ولا سليل النبي، ولا أدّعي أني الإله أو ابنه، أو جئت من ماء السَّماء.. أنا الوجع المصابر في مغاور جرحي المكابر.. قوة الحق اذا الباطل طغى، والأمان إذا فخخ الظالمون دروب الباحثين عن وطن.
أنا الجُرح العنيد، والعناد الأشد في وجه فرعون الإله.. أنا “اللاءات” كلها، والرفض المستميت في وجه الفرعنة.. أقتاتُ جرحي دون ذلة أو سؤال.. اتفيّأ الشمس المطلّة من شماريخ الجبال.. إذا دهري تآكل، وأحزاني بلغت مداها، فما زال شبابي يضج بعنفوانه، ويقدح ناراً ونوراً في وجه الدجى وأشباح الظلام.
ربّما يبكيني جائع، ويذلنّي محتاج عزيز النفس، ولكنّي أرفض الكون إذا زيفهُ يريد إخضاعنا، أو إرغامنا على أن نعبد تيجانه.. أرفض الفيزياء التي تكفّر من يخوض في علمها، أو تستبدل الحقيقة ببنت عمها.. أنا كافر في وجه الجوع الذي يريد إذلالانا.. كافر في وجه استلاب الوعي وتدجين البشر.. صرخة في وجه قدري اطلقها كالقذيفة: لا وألف لا.
* * *
أنا ابن الدبَّاغ الّذي يثور على واقعه كلّ يوم دون أن يكلَّ أو يملّ أو يستسلم لغلبة.. ابن الدبَّاغ الذي لا يستسلم لأقداره، ولا يُناخ، وإن كانت البلايا بثقل الجبال الثقال.. ابن الدباغ المجالد الذي يعترك مع ما يبتليه، ويقاوم حتى النَّزعِ الأخير.
ابن الفلاح الَّذي يتمرّد على مجتمعٍ مازال يقدَّس مستبديه.. ويقاوم سلطة لا تستحي عندما تدّعي.. سلطة تدّعي العدل، وطغيانها أكبر من محيط… تتعالى بمنخريها على وطني الكبير.. سلطة تخصخص المواطنة، وتوزع صكوك الغفران كما تريد، وتغيّب المساواة، وتنشر الفقر كالظلام الكثيف، وتحبس الحرية في كاتم من حديد.
أنا أُجرّم القتل ولا استسهله، ولا أشرب الدم ولا أسفِكه، ولكنّي متَّهم بشرب الكحول.. أنا ابن لأبٍ لا يبيع الموت ولا يهديه، ولا يجعله مقاساً للرجولة أو معبراً للبطولة.
أبي صانع الحلوى وبائعها، يأكل من كدِّه وعرق جبينه.. ينشر الفرح والطعم اللذيذ، ويرفض الحرب والدمار ونشر الخرائب.
أنا ابن أبي، لم أبنِ مجداً على أكوام الجماجم، ولم أحتفِ يوماً أو أفاخر باتساع المقابر، أو بطوابير النعوش الطويلة، ولم أطرب لركام الضحايا، ولم أضُخْ الكراهيَّة، وغلائلَ الحقدِ الدّفين.
* * *
أنا ابن أبي المُثقل بأحمال ثقال.. نكدُّ حد العي، ونشقى من غبش إلى عشيّة.. لم نُقِم الحزنَ يوماً في مبيتٍ، أو نبيع وهماً للضحية.. زيفوا الوعي بآلاف الخطب.. وأثقلوه بألف دس وفُرية.
روجّوا للدجل من أعلى المآذن.. أشعلوا النار ألفاً ونيف.. وأثقلوا الأرض بأحزان المياتم.. أطمعوهم بحور العين وأنهاراً من عسل وخمر.. وخبئوا المكر تحت المعاطف واللحى.. واخبئوا تحت العمائم ألف جلاد وليل.. نحن إن شربنا الكيف خلسة.. تسفح العين لآلئ، وإلى الله نسافر.
أنا لا أفاخرُ بهندً، ولا بمن تأكلُ الأكباد.. ولا أفاخر بنسبٍ أو قبيلة أو بقاتل.. لا أتسوّل, التاريخ زادي، ولا أدّعي سلطاناً وميراثاً.. ولا أدّعي حقاً من قبل آدم وحواء، أو ما قبل الثريا.
أنا لستُ من ماءِ السَّماء، ولا أفاخر, أني سليل لعلي أو فاطمة.. أنا أبي الدباغ والفلاح، وبائع الحلوى أنشر البهجة والفرح.. أبي كابد الدهر وعانى، واقتات من عرق الجبين.
أنا لستُ الأنا المثقلةَ بذاتها وذواتها.. أنا أقذف الأنا في وجهِ المستبد، غيرُ نادم، وأناضل لإزاحة الظُّلمِ الّذي أثقل كلًّ كاهل.. أنا الأنا الّتي تعتز وتفاخر، إنّها ليست من ماء السماء، وتقاوم من يراها إنها جاءت من روث الحمير.
أنا الحالمُ ابن الأحبّة.. أنتمي للحُلم الكبيرِ كبَر المجرَّة، بل كبَر هذا الكونِ الفسيح، الّذي يكسر المحابس ويسافر للبعيد، دون حدود أو منتهى.
* * *
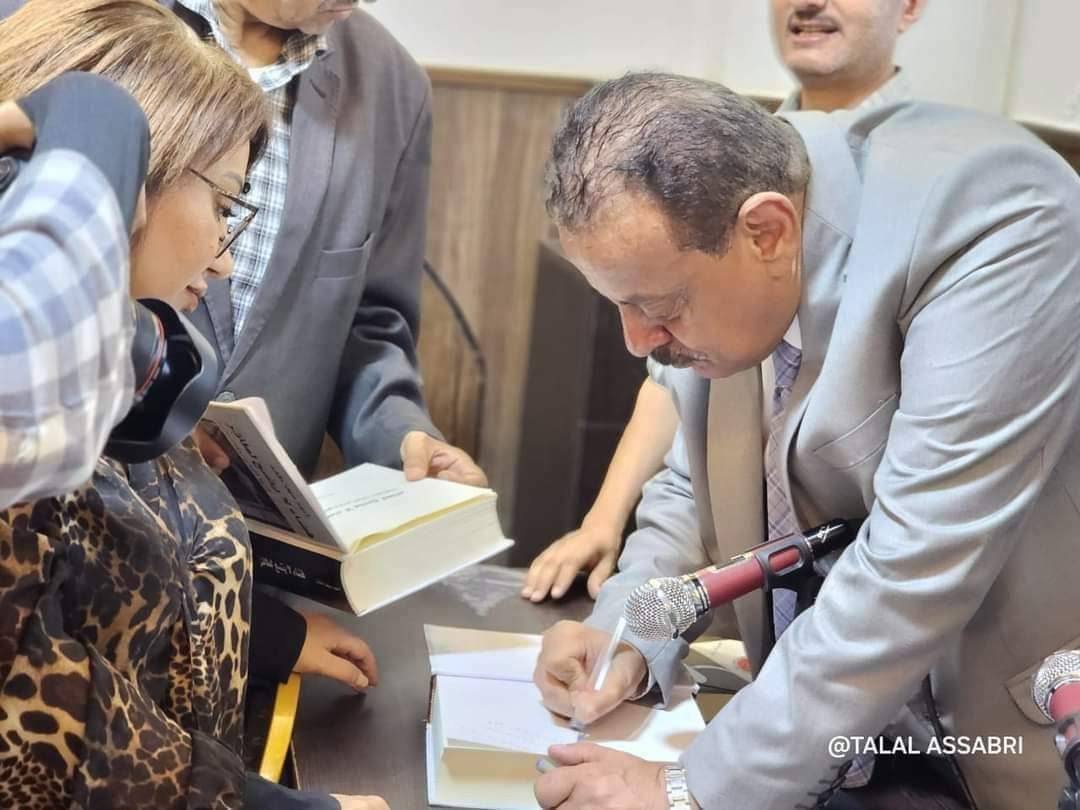
قراءة تحليلية للنص باستخدام تطبيقا الذكاء الاصطناعي DeepSeek & chat GP
يُعدُّ نصّ “فضاءٌ ضاق بطائر” لـ”أحمد سيف حاشد”، والمنشور في كتابه “فضاء لا يتسع لطاىر” نصًّا هجينيًا بين السيرة الذاتية والبيان السياسي والنثر الشعري، يحفل برؤى اجتماعية وأخلاقية حول العمل والكرامة والمواطنة والهوية
موقع النص وإشكالية القراءة
وإشكالية القراءة هنا تتمحور حول كيفية تحويل تجربة شخصية (سيرة الأب العامل) إلى خطاب نقدي للتراتبية الاجتماعية والوعي الجمعي، وكيف يتحول النص إلى نموذج مقاومة وجودية ضد الإذلال الطبقي والفرعنة الاجتماعية.
والنص يعمل على إنتاج أرشيف أخلاقي يقرأ الفقر والعمل كمصدر للكرامة، ويمارس إعادة تأهيل للقيمة الاجتماعية للعمل اليدوي في مواجهة خطاب الوصم الطبقي.
عنوان النص
العنوان مجازي قوي. “الفضاء” يرمز إلى المجتمع بطبقاته وتقاليده المتشددة، بينما “الطائر” هو الأب (والكاتب لاحقًا) الذي يحاول أن يحلق بحرية ويحقق ذاته من خلال العمل الشريف.
لكن هذا الفضاء “ضاق” به، أي أن النظرة الاجتماعية الضيقة والموروثات البالية هي التي تحد من حريته وتُقلص من فرصته في العيش بكرامة، مما يخلق تناقضاً صارخاً بين سمو العمل وضيق الأفق الاجتماعي.
الفرضية والمنهجية
الفرضية الأساسية: النص يستخدم سيرة الأب كحالة نموذجية لفضح منطق احتقار العمل في بعض مناطـق اليمن، ويحوّل التجربة الشخصية إلى خطاب عامّ عن المواطنة والعدالة الاجتماعية، عبر تقنيات بلاغية وسردية تستدعي الذاكرة الشخصية والاجتماعية وتُفعّلُها رمزيًا.
المنهجية: قراءة تركيبية تجمع بين النقد الاجتماعي-السياسي (تحليل البنية الطبقية والسياق السياسي: الجنوب الاشتراكي وما بعده)، والتحليل الأسطوري-الرمزي (الطائر، الصخر، الشجرة)، والتحليل الأسلوبي (الانتقال بين نبرة السرد والبيان الشعري)، مع توظيف مقاربة لسرد الذات لفهم التصعيد البلاغي من الحميمي إلى الكلي.
الزمان والمكان والسياق السياسي
والنص موشوم زمانيًا بمراحل: تجربة الأب في شركة “البِس” بعدن (مرحلة مبكرة)، عهد الاشتراكية في الجنوب (مرحلة حماية واعتزاز بالعمل)، وما تلاها من تغيّرات بعد الوحدة من جهة أخرى.
المكان محصور بين عدن، كريتر، مناطق الجنوب اليمني، ثم الانتقال معرفيًا إلى فضاءٍ وطني أوسع.
سياق النص: سياسي بامتياز، وفيه مقارنة بين حماية طبقات الفقراء في النظام الاشتراكي بجنوب اليمن، وإعادة تصاعد القيم التقليدية (القبلية/النسبية) التي تُعيد إنتاج احتقار المهن.
هذا السياق يعمل كمحور تبيان التناقضات بين سياسات التمكين الاجتماعي وسياسات الاحتقار الطبقي.
السيرة كأداة نقد
يستخدم الكاتب السيرة كـ”مرآة مجتمعية”: تجربة والده ليست فردًا فحسب، بل مثال تُعرض من خلاله علاقات السلطة الرمزية والمادية في المجتمع.
وتفنيد الجلود، تفاصيله الحرفية، وتكرار العودة إلى المهنة يشكلان مادة إثبات تجريبيًا لوجود الكدّ والعمل كقيمة.
والسيرة هنا تُقوّي الفرضية الأخلاقية: أن الشرف ينبع من العمل، لا من نسبٍ أو سلطة.
محاور رئيسية
1. العمل والكرامة
النص يقدّم العمل — ولو كان مهنة محتقرة اجتماعيًا — كمعيار أخلاقي. الأب لا يسرق ولا يغش، يأكل من “عرق جبينه”. الصورة المتكررة للعمل كقيمة تستدعي أفقًا أخلاقيًا مضادًّا لثقافة النهب والفساد.
هذه الثنائية (عمل شريف. نهب أو سلطة فاسدة) تهيمن على اقتصاد الرؤية في النص.
2. الاحتقار الطبقي والتراتبية
والنص يفضح وجود منظومة تراتبية تصنّف المهن والأصول، ويعرض أمثلة لغنائيات، أمثال شعبية، وممارسات تمييزية (الربط بين الدباغ والحلاق والجزار كمهن “ناقصي الأصل”). الكاتب لا يكتفي بالسرد، بل يحلل هذه الظاهرة ويصرّفها أخلاقيًا وسياسيًا: تمييز يرسّخ استبدادًا معرفيًا ومادياً.
3. الذاكرة والوفاء
العلاقة بين الراوي والأب تحمل بعدًا ذاكرِيًا؛ النص يُقيم فعل التذكّر كعمل مقاوم: تذكر الأب كإدانة لمن حاولوا طمسه اجتماعيًا.
للحنين هنا ليس نغمًا استسلاميًا بل وسيلة لتفعيل الوفاء الأخلاقي والسياسي (الراوي نائب شعب ومستقل سياسياً يرتبط بأبيه/الطبقة).
4. الهوية والمواطنة
النص يعيد تعريف الانتماء: المواطنة لا تُبنى على الأصل أو القبيلة، بل على ممارسة العمل والالتزام الأخلاقي.
هذا توجه يضع النص في خانة الخطاب الديمقراطي والحقوقي: المطالبة بمساواة رمزية ومادية.
5. المقاومة الوجودية
في الجزء الأخير يتحول الخطاب إلى منطق مقاومة وجودية وشعرية: “أنا الجُرح العنيد…” هذا التصعيد يحول الألم الفردي إلى فعل سياسي/وجودي: رفض الذل، رفض الفرعنة، ورفض الإذعان لهيمنة القيم الزائفة.
الصور والرمزية
الطائر: رمز الحرية، الحلم، والطيران فوق القيود.
عنوان النص يعلن تناقضًا: الفضاء الذي يجب أن يكون رحبًا صار ضيّقًا.
وهذا يشي بنسق رمزي مركزي: العالم لا يتّسع للإنسان الحر.
الصخر/الشجرة الشوكية/الصبار: رموز للانتصاب في وجه العسر، تعبير عن حياة تنبثق من الصعوبات.
وتُستخدم لتصوير الأب/الطبقة الفقيرة باعتبارها كائنات مقاومة.
العرق/العمل: رمز للكرامة والصدق الأخلاقي.
اللباس/العمائم/المنابر: تمثل أدوات السلطة المزيفة والذرائع لتوليد الكراهية (الدجل الديني والاستبداد).
الأسلوب واللغة
التدرج الأسلوبي من النثر الواقعي التفصيلي إلى خطابٍ شبه شعري يشي بفنية متقنة:
السرد الفكري: مقاطع تحليلية قانونية وتاريخية (إشارات إلى قوانين عهد 1976، إلى هتافات “سالمين”) تبرهن وعيًا نقديًا وتؤسس أطروحة اجتماعية.
التصعيد الشعري: إيقاع متصاعد، تكرارات (“أنا ابن…”)، صور بلاغية قوية، تجعله نصًا هجينيًا بين المقال والقصيدة.
اللغة العامية/الفصحى: النص مكتوب بالعربية الفصحى مع مفردات محلية وإشارات ميدانية، ما يمنحه طابعًا حميميًا ومقبولًا أكاديميًا في الوقت ذاته.
خطاب الرفض والالتزام الأخلاقي
والنص يرفض العنف والحقد لكنه يحتفظ بحق المقاومة الأخلاقية والسياسية. الكاتب واضح في إدانته للقتل والنهب، لكنه يعبر أيضًا عن غضب أعمق ضد بنية اجتماعية تنتج هذه الممارسات.
وهذا التوازن الأدبي يضمن مصداقية الخطاب: ليس مجرد انتقام وإنما دعوة لإصلاح ووعي.
استنتاج نقدي
“فضاءٌ ضاق بطائر” عمل أدبي وسياسي متماسك يستثمر السيرة والذاكرة كآليات نقدية لإعادة تأهيل قيمة العمل وإدانة التراتبية الطبقية. ا
النص ناجح في دمجه بين المادّي (تفاصيل الحرفة والمهنة) والرمزي (الطائر، الصخر)، وبين الخاص (قصة الأب) والعام (قضايا المواطنة والعدالة).
ويمكن اعتباره وثيقة أدبية توثّق تجربة شعبية/طبقية وتقدم خطابًا أخلاقيًا وسياسيًا متسقًا.
دلالات للنقاش المستقبلي
كيف يُقابل النصوص المشابهة خطابًا ثقافيًا وسياسيًا في اليمن ما بعد 2010؟
ما موقع أدب السيرة الطبقية في إنتاج الوعي الوطني؟
كيف يساهم الأدب في إعادة توزيع القيمة الاجتماعية للمهن اليدوية؟
وهذه أسئلة ينتج عنها مساحات بحثية مفيدة في الدراسات الأدبية والاجتماعية.
بيان انساني
وفي المجمل يعد نص “فضاءٌ ضاق بطائر” أكثر من مجرد نص سيرة ذاتية. إنه بيان إنساني وسياسي وأخلاقي. وهو دفاع عن كرامة الإنسان التي يُكسبها العمل والضمير، لا النسب والادعاء.
ويصور النص معركة مزدوجة: معركة الأب ضد الفقر والمرض، ومعركة الابن ضد التخلّف الاجتماعي والاستبداد السياسي.
نبل الكفاح
ومن خلال هذه القصة الشخصية العميقة، يقدم أحمد سيف حاشد نقداً لاذعاً لجذور العلل في المجتمع اليمني، معتزاً بانتماءٍ لا يقوم على النبل المفترض للدم، بل على نبل الكفاح والعمل الشريف.