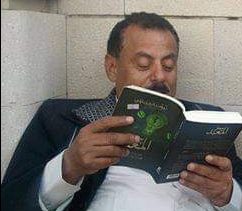قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «بوحٌ ثانٍ لهيفاء»

برلماني يمني
القراءة التحليلية لنص “بوحٌ ثانٍ لهيفاء» للكاتب والبرلماني اليمني أحمد سيف حاشد، والمنشور في كتابه” فضاء لا يتسع لطائر”، انجزت بتقنية الذكاء الاصطناعي
توطئة عن الكاتب
الإهداء الذي أورده الكاتب ، يكشف عمق التجربة: الملجأ، نيويورك، ساعة شعور.
كأن النص كله كُتب في منفى داخلي قبل أن يُكتب في منفى جغرافي.
في هذا النص أحمد سيف حاشد لا يظهر بوصفه برلمانياً، ولا سياسياً، ولا حقوقياً، بل إنساناً عارياً من الألقاب.
رجلٌ عاش طويلاً في مواجهة السلطة، لكنه هنا يواجه سلطةً أخطر: سلطة الخوف، وسلطة القطيع.
ما يميّز هذا النص أنه لا يتبرأ من ضعفه. الكاتب لا يتجمّل، لا يدّعي بطولة عاطفية، ولا ينتصر في النهاية. على العكس، هو مهزوم… لكن هزيمته صادقة، ومن صدقها تنبع قوتها.
هذا البوح لا يصدر عن شاعر مراهق، بل عن رجل خبر السجون، والمحاكم، والمنابر، والهتافات، ثم اكتشف أن أصعب معاركه كانت صامتة، تدور في صدره، بلا شهود.
حين يصير القلب وطنًا
ثمة نصوص لا تكتب الحب بوصفه عاطفة، بل تستدعيه ليقول ما تخشاه السياسة، وتُقحم العاشق في المشهد ليكشف وجه السجّان، وتحيل ارتباك القلب شهادةً دامغة على زمنٍ كاملٍ يضيق بالإنسان.
«بوحٌ ثانٍ لهيفاء» واحد من تلك النصوص النادرة التي تبدأ همسةً مرتجفة في صدر عاشق، ثم لا تلبث أن تتسع، طبقةً بعد أخرى، حتى تصير مرآةً لبلادٍ ترتاب من الضوء، وتخاف القلب حين يشتعل، وتعدّ البوح جريمة، والتفكير جنحة، والحلم تهمة مؤجَّلة.
هذا النص لا يُسحَب قسرًا إلى السياسة، بل يمضي إليها طوعًا، مقتادًا من حميمية العشق إلى فجاجة الاستبداد، ومن قلق الفرد إلى اختناق الوطن.
هذا التحليل لا يطارد المعنى السياسي للنص قسراً، بل يتبعه حيث قاده هو بنفسه: من خاص العشق إلى عام الاستبداد، ومن فردٍ مرتبك إلى وطنٍ مأزوم
هذا النص ليس مجرد بوحٍ عاطفي، بل سيرة وجدانٍ مكتوبة بالنار، واعترافٌ طويلٌ كتبه صاحبه وهو واقف على حافة نفسه، ينظر إلى داخله بلا أقنعة، ويترك الكلمات تنزف كما هي: ساخنة، مرتعشة، ومحمّلة بثقل التجربة.
حالة عصبية كاملة
«بوحٌ ثانٍ لهيفاء» نصٌّ يقوم على مفارقة قاسية:
حبٌّ جارف، مكتظ، ثائر… يقابله كبتٌ أشد، وقمعٌ أعتى، وخوفٌ متجذّر لا من الحبيبة، بل من العالم كلّه.
اللغة هنا ليست أداة وصف، بل حالة عصبية كاملة. الجملة تتنفس بصعوبة، تتراكم، تشتعل، ثم تنحبس مرة أخرى. الصور ليست مزخرفة، بل خانقة:
• مرجل النار
• الشرايين
• الأنفاق السرية
• الأقنعة
• الإعدام
إنها لغة رجل لا يكتب من الذاكرة، بل من قلب يحترق.
الحب في هذا النص ليس نشوة رومانسية، بل امتحان وجودي. الغياب ليس شوقاً عادياً، بل سقوط في الجحيم.
اللقاء ليس فرحاً، بل ارتباك يشبه انكشاف اللص لحظة القبض عليه.
حتى الغيرة، وهي غريزة بشرية، تتحول إلى معركة أخلاقية: نار تُكبَّل، وجنون يُلجَم، لا احتراماً للتقاليد، بل حفاظاً على نقاء المحبوبة، وعلى حقها في الضوء.
النص يتحول تدريجياً من بوح فردي إلى اتهام حضاري. فجأة لا يعود السؤال: لماذا لم ترَ هيفاء هذا الحب؟
بل يصبح: كيف لبلادٍ كاملة ألا ترى؟
وهنا يبلغ النص ذروته:
الحب جريمة.
الاعتراف إعدام.
التفكير كفر.
النور عدو.
إنها كتابة تفضح مجتمعاً لا يكتفي بقمع الجسد، بل يطارد المعنى، ويخاف من القلب حين يفكر، ومن العقل حين يحب.
إدانة منظومة قمع شاملة
هذا النص، وإن لبس قناع العشق والبوح الشخصي، هو في عمقه بيانٌ سياسي مكتوب بلغة القلب، أو على نحو أدق وثيقة اتهام ضد منظومة قمعٍ شاملة تبدأ من الجسد، ولا تنتهي عند “الدولة”.
حين يقول الكاتب إن الحب جريمة، والبوح جريمة تستدعي الإعدام، فهو لا يبالغ شعرياً، بل يصف منطق السلطة الأبوية –الدينية – الاجتماعية التي ترى في أي علاقة حرة تهديداً مباشراً لبنيتها.
هنا يتحول العاشق إلى مواطن مشتبه به،
والبوح إلى ملف أمني،
والغيرة إلى سلوك يجب ضبطه بالقانون أو العرف.
الحب، بهذا المعنى، يصبح أخطر من السياسة نفسها، لأنه يخلق فرداً حرّاً، والحرية – في الأنظمة القمعية – هي العدو الأول.
الجسد بوصفه ساحة صراع
النص مليء بصور الجسد المحاصر:
الشرايين، المرجل، الأنفاق، الاختناق، القناع.
هذا الجسد ليس جسداً شهوانياً، بل جسدٌ مُسيَّس، تُفرض عليه الرقابة، ويُطالَب بالإنكار، ويُجبر على التمثيل.
القناع الذي “يُظهرني عادي الحال” هو قناع المواطن الصالح، المطيع، غير المريب.
سياسياً، نحن أمام مجتمع يُجيد إنتاج الأقنعة:
يُخفي القمع باسم الفضيلة،
ويُجرِّم الرغبة باسم الأخلاق،
ويُحوِّل الإنسان إلى كائن مزدوج:
حياة داخلية محروقة، وواجهة خارجية مصطنعة.
سلطة الخوف
الخوف ليس من السلطة فقط… بل من المجتمع، أو ما يمكن تسميته بالرقابة الأفقية:
مجتمع يراقب نفسه بنفسه،
يشي، يروّج، يحاكم، ويعدم رمزياً دون حاجة إلى محكمة.
السلطة هنا لا تحتاج إلى سجن، لأن الضمير الاجتماعي صار زنزانة.
تفكيك الخطاب الديني – السياسي
في ذروة النص، يخرج الكاتب من الخاص إلى العام، ويطلق اتهاماً مباشراً:
مفتيها يسمِّي الحب نعومة حرب…
يفتي أن العلم مسيح دجال، والتفكير كفر بواح.
هذا ليس هجاءً دينياً، بل نقدٌ سياسي للفتوى حين تتحول إلى أداة حكم.
الفتوى هنا تؤدي وظيفة الأمن:
تُخوِّن، تُخوّف، تُجرِّم، وتُسكت.
سياسياً، النص يفضح تحالفاً قديماً:
سلطة الاستبداد + سلطة النص المؤوَّل = مجتمع خائف، معطوب، معادٍ للنور.
هيفاء: ليست امرأة فقط
في التأويل السياسي، هيفاء ليست شخصاً بعينه.
هي:
• الحرية المؤجلة
• الوطن الممكن
• الحياة التي تُرى ولا تُطال
• المستقبل الذي يُخنق بالشائعة والوصاية
غيابها يعني السقوط في الجحيم،
وحضورها يعني الإحياء “من أول وهلة”.
هذا قاموس سياسي بامتياز:
الوطن/الحرية لا تُعاش إلا حضوراً،
وحين تُغيب، يتحول الشباب إلى ذبول مبكر.
من البوح إلى البيان
النص يبدأ همساً، وينتهي صرخة ضد مجتمع مدمن رياء ونفاق، “يتنادى قطعاناً في وجه النور”.
هنا يتحول الكاتب من عاشق إلى شاهد اتهام،
ومن فرد مكسور إلى ضمير جمعي يقول ما لا يُقال.
خلاصة التأويل السياسي
«بوحٌ ثانٍ لهيفاء» نص عن الحب في الظاهر،
لكنه في الجوهر نص عن الاستبداد حين يتسلل إلى أدق مناطق الإنسان:
القلب، الرغبة، الارتباك، والبوح.
إنه يقول بوضوح:
حين يُجرَّم الحب،
فاعلم أن الحرية كلها في خطر.
وهذا – في حد ذاته – موقف سياسي شجاع، حتى وإن كُتب بلغة العشق
بلاد تصادر الطمأنينة
في نهاية هذا التأويل، يتضح أن النص لم يكن يبحث عن هيفاء بقدر ما كان يبحث عن حق الإنسان في أن يكون إنساناً. فالحب هنا ليس غاية، بل دليل إدانة؛ والبوح ليس ضعفاً، بل شجاعة مؤجلة؛ والارتباك ليس خللاً نفسياً، بل عرضاً سياسياً لبلادٍ تصادر الطمأنينة.
ينتهي النص دون خلاص، لأن الأوطان المريضة لا تمنح نهايات سعيدة، لكنّه يترك أثراً أعمق: يوقظ السؤال، ويكسر الصمت، ويعيد الاعتبار للقلب بوصفه آخر حصون الحرية.
هكذا يخرج «بوحٌ ثانٍ لهيفاء» من كونه اعتراف عاشق إلى كونه وثيقة احتجاج ناعمة، تقول بهدوء قاتل:
إن أخطر ما يواجه الاستبداد ليس الهتاف،
بل إنسانٌ يحب… ولا يخجل،
ويفكّر… ولا يستأذن،
ويبوح… ولو دفع الثمن
القيمة الأدبية والإنسانية
هذا النص ينتمي إلى أدب الاعتراف المقاوم:
اعتراف لا يطلب الغفران، ولا يلهث خلف التعاطف، بل يضع القارئ أمام مرآة غير مريحة.
هو نص عن الحب، نعم…
لكنه أعمق من ذلك:
هو نص عن حق الإنسان في أن يشعر دون خوف،
وفي أن يرتبك دون أن يُدان،
وفي أن يحب دون أن يُعدم معنوياً.
إنه بوح لا يُقرأ مرة واحدة،
لأنه لا يُفهم من الرأس،
بل من الصدر
من تلك المنطقة التي تؤلم حين نطيل الصمت.
باختصار
هذا النص ليس جميلًا بالمعنى السهل،
لكنه صادق إلى حد الوجع،
والصدق حين يبلغ هذا الحد
يصبح ضرورة أخلاقية.
نص “بوحٌ ثانٍ لهيفاء”
أحمد سيف حاشد
الإهداء: إلى اصدقائي بالملجأ “الشلتة” في البرنس – نيويورك
بعض شعور أعيشه هناك لساعة..
كنت أخُبِّئُ ثوران حبي اللاعج، وأوجاعي المنبعجة بالألم المكتظ في عمقي الداجي وأنفاقي السرِّية.. أقمعها بقسوة، وأسدُّ منافذها بإحكام الخائف من همسة حب تفلتُ منه في غب النوم.. أخرجُ من عمقي ودهاليزي؛ وأحاول ألبس قناعاً يظهرني عادي الحال، فيما واقع حالي مصلوب بين شقاء وعذاب.
أكتم سري حتى يبلغ ذروته ودورته القصوى.. أبلع غصصي بمرارة.. أغتلي في مرجل ناري، وأداري النار عن الأعين في شراييني.. اكتم صوت غلياني الثائر، وأحاصر أبخرتي بإتقان، وأترك أنبوباً إلى قنِّينات نبيذي، لأسكر سراً وحدي منفرداً، بحبي الناقص والمقموع بكتماني.
حرصتُ أن لا يعرف أحد ما بي من شوق وشجون، وما يجيش فيَّ، وفي صدري يثور.. في صدري ثورة أخمدها بطغيان.. داريت ما يحدث في أعماقي عن الأعماق.. منعتُ نفسي عن نفسي، ومنعتُ الصمت أن يسمع صمتي، وقمعتُ الغيرة والبوح وما فيَّ يجوس في مجاهل أغواري.
إذا غبتِ يوماً يا هيفاء عن الكلية، أسقط في ندم يوم مهدور.. أهوي إلى قاع جحيمي.. يكويني ويشويني غيابك.. شبابي في غيابك ينحسر ويذبل.. أشعر بأفولي وأذوي كشمعة.. أهيم على وجهي في فلوات ضياعي، وأموت بحسرة، حتى أراك ثانية فأحياء من أول وهلة.
كنتُ أضطربُ وأرتبك، وأجزع إن حاولتُ أسأل عن حالك، أو أحدثك بأمر تافه في لقاء عابر، وحالي مرتجف مثل اللص المقبوض للتو عليه.. كنتُ وأنا أحدثك أشعر أن جهازي العصبي فيه ألف خلل، وأنا أقف أمامك في لحظة إرباك، وكأن على رأسي عفريتاً لا طير.
لماذا شجنك لا يسألك؛ لماذا هذا الشاب جَزِعٌ مضطرب خائف بين يديك..؟! يا ترى ما في جعبته يداري..؟! أهو الحب؟! ما سر هذه الربكة؟! حبك جارف يا هيفاء.. هدهدي جزعي.. خففي روعي.. ابتسمي حتى أروق.. هل كنتِ ضريرة؟! أم كان غباؤك فاحشاً لا يرى إنساناً مثل الشجرة يهتز أمامك، وكأن عاصفة تريد أن تقتلعه من تحت القدمين!!
حاولت مراراً في طي الليل الداجي، أن أستحضر روحك بين اليقظة والنوم، لأبلغك ما فيَّ من شوق وهيام.. بكل حواسي حاولت أن أبلغك بعض شجوني، وما يجيش فيَّ من حب لاعج، غير أني وجدتُ نفسي حسير فراشي. وحواسي معطوبة وأنا أدوم فراشي.. لا إسراء لدي ولا معراج، ولا مصباح علاء الدين.
كنتُ أغار عليك يا هيفاء، وكتمتُ عن الناس نارا تأكلني بجنون الغيرة.. كبلتُ الغيرة بناري، وبأصفاد حديد السجّان، وألجمت جنوني في أعماقي، غير أن جنون الغيرة مهما بلغت فيني، لن تبلغ أن تخمد نورك، أو تفرض حجاباً أو تضرب برقع على شروق شموسك، أو تسدل سواد الموت في الليل الداجي على وجه القمر البدر.
قتلتني من زعمت أني متزوج ولدي أبناء وبنات.. كذب وهراء.. هل كان تلبيس أم تظليل أم كيد نساء.. هل كان الباعث حرصاً أم كان الباعث أمر آخر؟!.. لا أدري حقيقته.. ما عهدتُ حرصاً يدفنني حياً، ويفسد أيامي ومستقبل كنت أراه جميلا، وبألوان الزهر.
أنا المهدود بأحمالي.. أحمالي صارت أثقل من جبل أحمله بصبر بعير.. أنا من بلاد فيه العشق جريمة، والبوح جريمة تستدعي الإعدام، وفيها الحزم وفيها الشدة، ولزم صاحبها أن يكون لغيره عبره..
أنا من بلاد ترى الحب عدواً أول.. ومفتيها يسمِّي الحب نعومة حرب.. يفتي دون سؤال.. يفتي أن العلم مسيح دجال، والتفكير كفر بواح.
أنا من بلاد مدمنة رياءً ونفاقاً.. تتنادى قطعاناً وحشوداً في وجه النور.. صارت أقنعة الزيف تتقزز مما تخفيه.. تستنفر قواها وتحتج حين تشاهد قبح الواقع يتبعج.. تتفسخ من قُبح باذخ في وجوه بلغت دمامتها الذروة.. وجوه تتوحش في وجه الحق، ومدونة زادتها فساداً وقتامة.
***